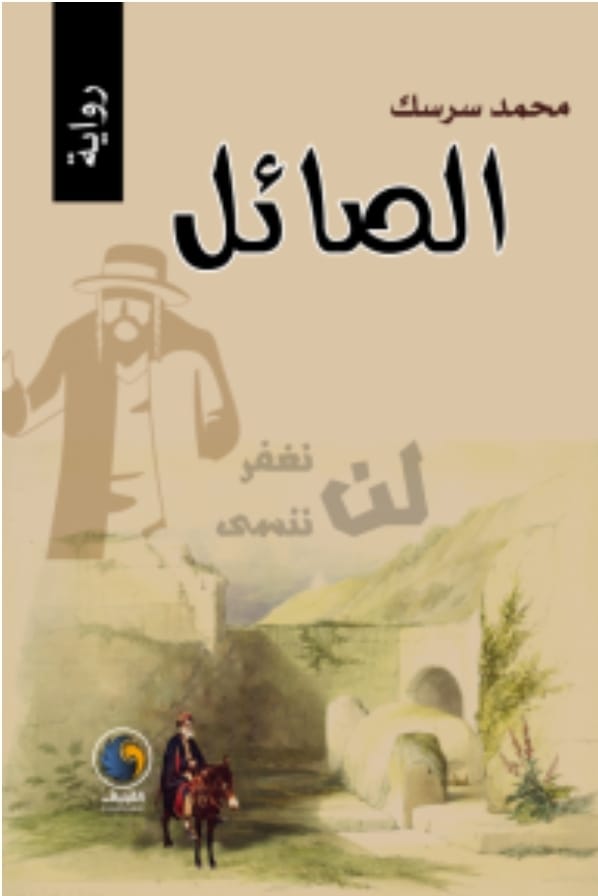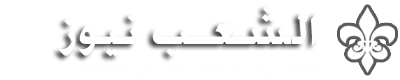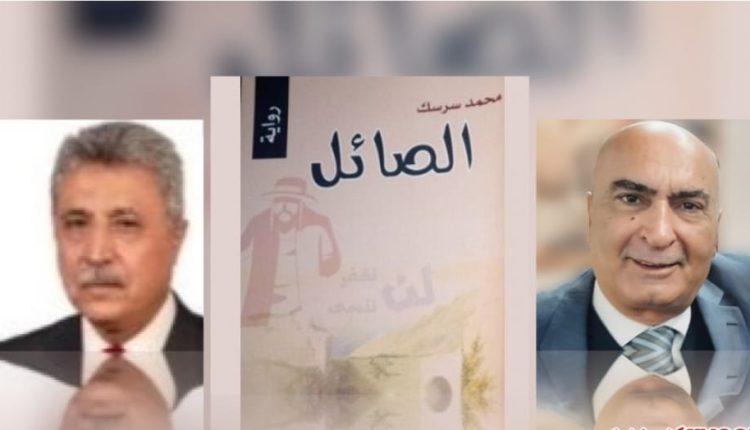
إضاءة على رواية “الصائل” للكاتب محمد سرسك.
الشعب نيوز:-
قراءة: عفيف قاووق – لبنان.
رواية الصائل للكاتب الأردني محمد سرسك صدرت العام 2024م عن دار الفينيق للنشر والتوزيع. يقدم لنا الكاتب من خلالها إطلالة على مرحلة تاريخية معينة بدءًا من بداية تفكك السلطنة العثمانية ومرحلة الإستعمار أو –الإنتداب- الإنكليزي على فلسطين إلى بدايات عمليات التغلغل الصهيوني اليهودي إليها، أي من أواخر القرن الثامن عشر ١٨٨٠م تقريبا ولغاية ١٩٢١م.
بدهاء وحنكة يتغلغل اليهودي أبو إسحق متنكرًا بهئية البائع المتجول إلى إحدى القرى الفلسطينية بعد أن استطاع إقناع أهلها بأن وجوده في خيمته لاضرر منه، فأصبح اسمه مألوفًا في القرية، فالنّساء يجْذِبُهنَّ ما عنده من أقمشة وزينة وعطور، والرّجال وجدوا فيه مُتنَفسَّا لهم في المَساءاتِ القرويّة الطَّويلة خاصة بعد أن جذبتهم حكاياه التي كان يقصّها عليهم، إلى درجة أصبح أهلُ القرية معتادينَ على وجوده في شوارعهم وبين بيوتهم.
لاحقًـا تباينت أراء أهل القرية حول قدوم أبي إسحق إليها، وتوزعت وجهات نظرهم ما بين متوجس من قدومه ومطمئنّ له. هذا التوجس حمل رايته المدرس في القرية الأستاذ عماد الذي لمْ يكُنْ يروق له ما يسمعه حوْل أخبار أبي إسحاق أو حكاياته الكثيرة، ولمْ يكُنْ مرتاحًا لإقامته في الجِوار ولِسهْرات السَمَر التي يُقيمها، وكيف استطاع أن يكسَب ثقة الرّجال دون تكبّدهم عَناء السُّؤال عنْه، مَن هو؟ وماذا يريد؟.
بالمقابل لم يكنْ المختارُ قلِقًا، ولم تفلحْ تساؤلات عماد في إثارة مخاوفه، فالمختار مقتنع تمامًا بأنّ الرجل لابدَّ أنّه راحل لكونه تاجر. فلا داعي للتفكيرِ كثيرًا في هذه الأمور، “نعم لقد طالت إقامتُه قليلًا، لكنْ سيأتي يومٌ ويكملُ طريقه، وترجِع الأمور إلى ما كانت عليه، فلا داعيَ للقلق”. وفي موضع آخر عندما حاول عطية تنبيه المختار إلى عمليات النقش والرسومات التي يقوم بها رجال أبي إسحق قلّل المختار من هذه الهواجس وكانت ردة فعله “ما لنا وله، خلينا بحالنا أحسن”.
تبين الرواية كيف أن اليهودي –الصهيوني أبا إسحق بعد أن كسب ثقة أهل القرية بدأ بتنفيذ مخططه وتدخله في شؤون القرية من نافذة الضيق الاقتصادي الذي بدأت علاماته تقضّ مضاجع المختار وأهل قريته، هذا التدخل ظاهره الإدعاء بمساعدة الفلاحين وتزويدهم بتراكتور زراعي أما باطنه فهو الاستيطان وامتلاك الأراضي بعد إغراق أصحابها بالديون وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم. نتيجة استدانتهم المال بفوائد مرتفعة فقد اضطر المختار لكي يسدد الضرائب للسلطنة العثمانية أن يلجأ لأبي إسحق ويستدين منه مبلغ مئتي ليرة عثمانية، لكن سند الدّيْن كُتب بثلاثمئة ليرة، وبفترة سداد ثلاث سنوات.
كما تبرز الرواية السعيّ الدائم لليهود للتخلص من عقدتهم التاريخية، وهي عدم وجود أرض لهم لذا نراهم لا يتورعون عن تزوير التاريخ لا بل محاولة خلق تاريخ وهمي لهم كما في محاولة أبي إسحق الإدعاء بأن الضريح الموجود في القرية قد يكون لأحد أنبيائهم منذ آلاف السنين، ويطلب أن يخصص له يومًا واحدًا فقط في السنة ليزور الضريح هو ورجاله وممارسة عبادتهم، كما تذكر الرواية كيف كان اليهود يستميتون في إختلاق أدلة وهمية تثبت أحقيتهم بهذه الأرض من خلال عمليات الحفر والتنقيب التي قاموا بها للعثور ولو على إشارة بسيطة تثبت دعواهم. ولم يتورع أبو إسحق عن الطلب من الأهالي: “أعطوني قطعة صغيرة من الأر ض، حتّى أقُيم لي بيتًا صغيرًا”.
كما تشير الرواية إلى تصميم المستوطن الصهيوني على طمس كل ما يؤكد هوية هذه الأرض العربية واقتلاع كل الجذور التي تدل على عراقتها حتى لو اضطر إلى اقتلاع الشجرة المباركة في القرية، بطلبه من عطية أن يسكب محلول سام حول جذعها لإتلافها “سأعطيك سمادًا خاصًّا لها حتى تظل نضرة ويانعة لكن هذا السماد بالذات لا تستعمله إلا في الأيام الممطرة عندما تكون الأرض مبتلة”.
يبدو أن زرع العملاء والاستفادة من دناءتهم من دعائم السياسة الصهيونية وقد ظهرت في استمالة أبي إسحق للخادم عطيّة وهو مجهول النسب، وأوكل إليه مهمة التجسس وإطلاعه على كل شاردة ووارد في القرية، وقد راق هذا الأمر لعطيّة الذي يقول: “لست صبيًّا عند المختار، لا أحد يمُنّ عليّ بعد اليوم، وسأجلس مع الرجال كواحد منهم وليس خادمًا لهم، وسأنفذ ما يطلبه مني أبو إسحق بسرية تامة، وسأخبره بأسماء جميع عائلات القرية، وأفرادها ووجهائها، وأراضي كل عائلة فيها، ومواشيهم ومحاصيلهم، وكذلك مداخل القرية ومخارجها.
لأجل تنفيذ مخططاتهم تشير الرواية إلى تلك المجامع اليهودية التي كان اليهود يعقدونها سواء في القدس الغربية أو في المدن الأوروبية مثل فرنكفورت ولندن وغيرها، وتكشف عن بعض ما كان يدورفي تلك المجالس التي كانت بإشراف
اثني عشر صهيونيا، “كانوا قد قدموا من مختلف أنحاء العالم.
وفي لمحة عن تلك المجالس والمواضيع التي تبحث أشارت الرواية إلى ذاك الاجتماع الذي عقد في القدس الغربية حيث اجتمع هناك اثنا عشر شخصًا: يهوذا ،شمعون، روبين، لاوي ،ساخر، زبولون، جوزيف، بنيامين (أبواسحق)، دان، نفتالي، كاذا، أشار. وكان شعارهم التوراتي “(كل مكان تطؤه أخامص أرجلكم لكم أعطيته) هكذا قال الرب”. واللافت أن اليهود دائما ما يغلفون دعواهم بالرجوع للتوارة أو التفاسير الدينية، وعن تعلقهم وتقديسهم للرقم 12، تورد الرواية بعض ما جاء من حوار بينهم:
لاوي: ها نحن اثنا عشر رجلًا.
نفتالي: أبراج السماء اثنا عشر برجًا، نحن أبناء السماء.
ساخر: عدد الشهور اثنا عشر شهرًا، نحن أسياد الزمن.
جوزيف: إنه رقمنا المقدس حتى البنك الفدرالي الأمريكي ولد باثني عشر فرعًا.
ليبدؤا بعدها باستعراض ما تم إنجازه من إنشاء ما يقارب أربعين مستعمرة زراعية وسكنية في فلسطين حتى الآن، كان أولها (بتاح تكفا). كما برز لديهم الإصرار على جذب جميع اليهود وإغرائهم للقدوم سواء من المنطقة العربية أو أوروبا. بعد أن استعرض بنيامين (أبو إسحق) خرائط المناطق المهجورة والأراضي البور والمناطق الساحلية والداخلية غير المشغولة، قال:”يجب شراء ما هو مملوك بقدر ما نستطيع، أما ما هو غير مملوك فسيكون لنا في نهاية المطاف”.
لقد أبرزت الرواية كيف أن اليهود إستطاعوا التحكم بالحركة المالية والإقتصادية في أوروبا وغيرها من مدن العالم عن طريق ولوجهم عالم المال والصيرفة والبنوك والقروض والتمويل، لكون أوروبا كانت تحظر على اليهودي التملك فلجأ معظمهم إلى الوساطات المالية. وعن السيطرة المالية يقول يهوذا: نحن من يمسك المال دائمًا وهو ضروري في كل الأحوال في السلم والحرب، إنه عِجلنا الذهبي منذ الخروج وحتى الآن، ونحن ننتظر الحرب كي نعرف أين نطلقه. كما تحدثت الرواية عن النظرة الأوروبية التي كانت سائدة تجاه اليهود، فيصف اليهودي “دان” تلك النظرة بالقول: “لقد أطلقوا علينا الكثير من الصفات، مرة يهودي البورصة، ومرة هذه المدينة مليئة بالذباب واليهود، ويؤكد زميله يهوذا هذا بالقول: نعم بالنسبة إليهم نحن إما تجار أو مرابون”.
لقد كشفت الرواية عن تقاطع مصالح الأوروبيين واليهود وإن إختلفت أدافهم بعد أن أصبح اليهود يشكلون عبئًا على دول أوروبا، وفي هذا يقول اليهودي ساخر: “إنهم لا يريدون رؤيتنا بينهم، فلنرجع قليلاً بالتاريخ، كم مرة تم اتهامنا بالدم وتسميم الآبار، كم مرة سمعنا أن الخلاص هو تنصّرنا، كم بلد فرض علينا الجيتوات”.
هذه المصلحة الأوروبية والرغبة في التخلص من اليهود التقت مع رغبة اليهود أنفسهم للتخلص من عقدتهم التاريخية وهي البحث عن وطن قومي لهم، وفي هذا يقول يهوذا: سنطرق كل الأبواب، توجهنا أيضًا إلى روسيا القيصرية، وحصلنا عن طريق وزير داخليتها بأن تبذل جهودها ومساعيها لدى تركيا؛ لتسهيل دخول أبناء شعبنا إلى فلسطين وتوطينهم فيها. وفي هذا المجال تبرز الرواية محاولات اليهود ومكائدهم لإجبارالسلطنة العثمانية على منحهم التسهيلات اللازمة لدخول فلسطين :” «بناء على حديثي مع السلطان عبد الحميد، فإنه لا يمكن الإستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها السياسية ، أو عن طريق الزجّ بها في حروب تُهزم فيها أو مشكلات دولية أو بالطريقتين معًا وفي آن واحد»”، هذا ما كتبه هرتزل بعد محاولاته مع الدولة العثمانية من أجل السماح لليهود بالقدوم إلى فلسطين أو منحهم أية صفة على أرضها.
في محور من محاور الرواية تطرقت إلى الأوضاع المتردية التي بدأت تعصف بالسلطنة العثمانية وبداية الصراعات الداخلية فيها حيث لم يعد السلطان هو السلطة الوحيدة، وبروز قوى داخلية أخرى، مثل حزب الاتحاد والترقي وانضمام عددٍ لا بأس به من الجيش إلى هذا الحزب بشكل سرّي، واستطاع الوصول لسدة الحكم والتي كانت من أولى سياسته أن عمد إلى فرض اللغة التركية كلغة رسمية، في محاولة منه لتتريك البلاد العربية، وكردّة فعل على تلك المحاولة بدأت تتشكل جماعات وأحزاب ، فظهرت كل من جمعية الإخاء العربي، والمنتدى العربي، والعربية الفتاة، وجمعية بيروت الإصلاحية، وجمعية الجامعة العربية في القاهرة، والجمعية القحطانية، وارتفعت الأصوات التي تنادي بالمساواة بين القوميات.
انطلاقًا من الوضع المتأرجح للسلطنة العثمانية أصبح الأوروبيون يسيطرون على التجارة الخارجية فيها، ويحظرونها على أبناء الدولة، بحجة سداد الديون، بعد أن فرضت الدولة الدائنة وجود بعثة مالية دائمة للإشراف على الأوضاع الاقتصادية وذلك ضمانًا لديونها، وحرمان التجار من القيام بالتجارة الخارجية.
وتُذكّر الرواية بالممارسات القمعية والعنصرية التي مارسها الأتراك خاصة ما اعتمده جمال باشا من سياسة معادية للعرب، واعتقاله للكثير من دعاة اللامركزية والقومية العربية، واستحداث مجلس عسكري في مدينة عالية اللبنانية لتعذيب المنتمين للجمعيات العربية، وقمعه للصحافة والصحفيين في حين سمح بإصدار صحيفة «صوت العثمانية» في فلسطين التي كانت تعبر عن لسان حال اليهود باللغة العربية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أصبح الجنود يبطشون بالناس وينكلون بهم، ويصادرون المحاصيل، مما أدى إلى انتشار الجوع والفقر، والذي كانت ذروته المجاعة التي حصلت في لبنان، وبشكل أقل عانى منها أهل فلسطين وسوريا والأردن.
كما تبرز الرواية تعلق الفلسطيني بأرضه وعدم التفريط بها أو التنازل عنها للغريب في إشارة شيخ القرية الذي قال: إن الأرض لا تذهب إلاّ لمن يرِث، ونحن نتوارثها من مئات السنين وكلنا يعرف الآخر، لم نسمح طيلة حياتنا بأن يدخل بيننا دخيل ويستملك أرضا من أراضينا، لو فتحنا هذا الباب يومًا فقد نصبح غرباء في قريتنا يومًا ما.
وبهدف الإستقصاء عن نوايا اليهود المبيتة كانت جولة عماد مع صديقه (حسن) في كل أنحاء فلسطين للتحري عن الهجرة اليهودية، ووجدا أنّ اليهود ينتشرون في أنحاء فلسطين المختلفة، بل ويقيمون مستعمرات زراعية أو مستوطنات وكل واحدة منها كان فيها كنيس ومدرسة دينية، وإدارة مشتركة ونظام حراسة جماعي. وكانت كثيرة مثل: ميكيفا إسرائيل ،بتاح تيكفا، ريسون ليتسيون، زخرون يعقوب، روض يبنا.
وتختتم الرواية بالإشارة إلى وعد بلفور وتداعياته فقد استقبله اليهود في كل الأنحاء بالفرح والإحتفال، وأطلقوا عليه اسم الميثاق أو البراءة. وبدأت بذرة المقاومة والمواجهات تظهران للعلن بين العرب واليهود – والإنكليز من خلفهم – كما حصل عند اجتماع المحتفلين اليهود عند باب الخليل، وقيام العديد من وجهاء المدينة العربية بإلقاء الخطب الحماسية المندّدة بالإحتلال البريطاني، والمشروع الصهيوني والانتداب، ومن ضمن المتحدثين كان أمين الحسيني وعارف العارف وآخرون، وأثناء ذلك قام مجموعة من الشباب اليهود بالتهجم على بعض الحاضرين، فردّ عليهم الفلسطينيون بقوة، وهاجموهم فأطلقت القوات البريطانية النار لحماية اليهود، وسدّت باب الخليل، وأنذرت الفلسطينيين لمغادرة المكان وإلا سوف يتعرضون لإطلاق النار. ومنذ ذلك الوقت والفلسطيني يحمل صليبه ويسير على درب الجلجلة.
ختامًا رواية الصائل تكمن أهميتها في كونها تؤرخ لفترة زمنية تكاد تكون مهملة لدى الكثير من الكُتاب ومنسيّة أيضا لدى العديد من القراء. لقد أعادتنا هذه الرواية الى بداية البدايات حيث التقت مصالح المستعمر مع أطماع المُحتّل، وكانت الضحيّة ولا تزال فلسطين.