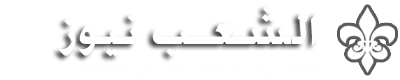الاكتشاف المشترك: هل نعيش لنكتشف أم نكتشف لنعيش؟سعيد ذياب سليم
الشعب نيوز:-
التمهيد:
حياتُنا معركةٌ مستمرة، نخوضها بحثًا عن ذواتنا، وعن من يشعر بقلقنا قبل أن نبوح به.
وحين تتعثر الخطى، لا نحتاج إلى خارطة، بل إلى رفيق يبدد الشك بالطمأنينة، ويمنح الغموض طعمًا من الدهشة والأمل.
رفيقٌ نكاشفه مخاوفنا، ونستند إليه حين تثقلنا الحياة، فينير لنا في العتمة شمعة.
فالمستقبل ليس أحداثًا متتابعة، بل حوارٌ مفتوح بين “الأنا” و”النحن”، بين الحلم الفردي والمصير المشترك.
المحور الأول: الاكتشاف المشترك كفلسفة إنسانية
في هذا الزمن الذي يغرينا بالانعزال، تبدو فلسفة الاكتشاف المشترك تذكيرًا إنسانيًا بأن المعنى لا يُولد من الوحدة، بل من العلاقة، من تلاقي الأرواح التي تتشارك الدهشة والبحث.
لا نُدرك جمال الحياة إلا حين نعبر إلى الآخر، حين تتقاطع النظرات في لحظة تعارف عميق تنبع منها “الأنا”. فالكينونة لا تتشكل في عزلة التأمل، بل في دفء علاقة صادقة، تذوب فيها الحدود، ويولد منها المعنى الحيّ.
العلاقة ليست وسيلة للفهم فقط، بل تربة ينمو فيها الوعي. وحين نرى الآخر كذات كاملة لا كمرآة، يصبح اللقاء فعل اكتشاف متجدد، لا حقيقة جاهزة. ومن هنا، لا تُفهم الذات إلا بالانفتاح على الآخر – فردًا كان أو حضارة – كما شهدنا في حوارات الفكر الإسلامي والفلسفة الإغريقية، أو تمازج الفنون الأندلسية والأوروبية.
وإذا كان الاكتشاف بين البشر يُعمّق الفهم، فإن أسمى صوره تظهر في العلاقة مع الله؛ حيث لا يُخاطَبُ كـ”هو” بعيد، بل كـ”أنت” حيّ، حاضر في الوجدان، توقظه المناجاة وتحتضنه القلوب.
هكذا يغدو الاكتشاف موقفًا وجوديًا، لا لحظة عابرة. هو أسلوب عيشٍ يعيد تشكيل الذات والعالم، خاصة حين يتم في صحبة الآخر. وعندما تثير ابتسامة إحداهنّ الفضول، وتوقظ رنّة ضحكتها سبات قلب، تهزّه، تربكه، وتُلقي به في درب اللهفة والاكتشاف، يُدرك أن اللقاء ليس مصادفة، بل ولادة جديدة للمعنى.
فالاختلاف لا يفسد المعنى، بل يوسّعه. وما نكتشفه سويًا ليس تطابقًا، بل تناغم يولد من الإصغاء، من رقصة اللقاء التي تجعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا… في وجه الآخر.
المحور الثاني: من الفلسفة إلى التجربة – كيف يتجلّى ذلك في العلاقات
يتباين مفهوم العلاقات بين مجتمعٍ وآخر: ما يُعدّ مألوفًا في ثقافةٍ ما، قد يبدو شاذًا في أخرى؛ وما تسمح به القوانين، والشرائع، والأعراف، قد يُنبذ في بيئاتٍ مختلفة. وبين الرفقة، والصداقة، والحب، يدور حوارٌ طويل، يتشكّل من ثقافة المجتمع وتجارب أفراده.
حين ينسجم شخصان، تبدأ بينهما رحلةُ اكتشاف: كيف يتعاملان مع الأشياء، مع الأفكار، مع الانفعالات؟ يتنافران في بعض التفاصيل، ويلتقيان في أخرى، فيكمل أحدهما الآخر. لكن حين يتحوّل أحدهما إلى مجرد انعكاسٍ للآخر، كما في المرآة، يتسلّل الملل والنفور، وتفقد العلاقةُ دفئها.
نحن لا نبحث عن مرآة، بل عن “نصفٍ آخر” لا يُنهي الرحلة، بل يفتح طريقًا جديدًا. ننسجم معه دون أن نذوب فيه، ونواصل معًا السير في رحلةٍ لا تتوقف عند اللقاء، بل تبدأ منه: رحلةٌ مليئة بالاكتشاف، والدهشة، والتغيّر المشترك.
ما يزال الرجلُ للمرأة، والمرأةُ للرجل، حكايةً تبعث الحيرة وتثير الدهشة. وفي لقائهما تكمن مغامرةٌ تبدأ ولا تنتهي.
يبحث كلٌّ منهما عن الأعذار، ويغتنم الفرص ليرى الآخر، ليُطفئ نار الشوق، ويتذوّق سحر الحضور المشترك. تتبادل العيون نظراتٍ مفعمةً بالحب والاحترام، ويغدو اللقاءُ ضرورةً لا رغبةً عابرة.
يتقاسمان الفرح، ويتساندان في وجه الهمّ، فتصبح الرحلةُ أخفّ، والحياةُ أعذب.
تبدأ رحلةُ اتخاذِ القراراتِ المشتركة: كيف يلتقيان في إطارٍ اجتماعي يُرضي الأسرة ويُرضي المجتمع، ليغدو الغريبان قريبين، يتقاسمان الحلم، ويتبادلان الأمل، ويسندان بعضهما في وجه الألم والخوف؟ يتحوّل كلٌّ منهما إلى ملاذٍ للآخر، يحفظ له حقَّه في أن يكون، وأن يحلم، وأن يتغيّر.
لكنّ الطريق ليس معبّدًا بالحنين وحده، بل تمضي العلاقةُ عبر محطاتٍ من التفاوض والمساومة، وكأن الحب واقفٌ بينهما متوجّسًا: هل ينهزم أحدهما تحت وطأة القرار؟ هل يخذله الحبيب حين يحتاجه قويًا؟
قراراتٌ مصيرية تبدأ من العمل والإقامة، ولا تنتهي بالهجرة أو العودة، لكنها تصل في عمقها إلى أهمّ سؤال: هل يستطيع كلُّ طرفٍ أن يعترف بالآخر كإنسانٍ مستقل، له صوته وحقّه في الوجود؟ ذلك هو التحدّي الأصعب، وغالبًا ما تواجهه المرأة أولًا.
المحور الثالث: علاقة صداقة تنتهي بزواج – نموذج للاكتشاف المشترك
الإنسان كائنٌ اجتماعي، يهرب من العزلة ويسعى إلى الانتماء. يتجاذب فيه الجنسان كتجاذب طرفي المغناطيس، ذلك التجاذب الأزلي الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، ودفعهما إلى معانقة الجهد، والبحث، والمعرفة، ليعرفا الله، ويتعرّفا إلى ذواتهما.
يتجدّد اللقاء كلما التقى رجل بامرأة أقداره.
وحين يلتقي شقّا العاطفة في طريقٍ رسمه القدر، ووضع له الشرع الإلهي ضوابطه، تُوقد بينهما جذوةُ المودّة والرحمة، كما أشار القرآن الكريم في وصفه لهذا الرباط:
“ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.” (الروم: 21)
قد يلتقيان في قاعةِ دراسة، أو ميدانِ عمل، أو تصنع لهما الصدفة موعدًا عابرًا. ومن هناك، يسيران على جسر الصداقة الذي قد يقود إلى الزواج.
وتبدأ هذه الوحدةُ الاجتماعية رحلتها، باعتبارها مكوّنًا أساسيًا في بناء المجتمع. ولها في كل يومٍ مغامرةٌ وتحدٍّ جديد، وتطلّعاتٌ يملؤها العملُ المشترك، في نضالٍ مستمرٍ لتحقيق الأهداف. ويأتي الطفلُ الأول وقد تهيّأت له ظروفُ الحياة، فيبتسم لوجه أمه، لكنه ينطق بكلمته الأولى: “بابا”، ليبدأ ذلك العتب اللذيذ، وترسم الأسرة ملامحها وأدوارها في ظلّ منظومةٍ من القيم التي ينادي بها الشرع.
لكن حين يغيب الوعي، قد يظنّ البعض أن العروس مجرد دمية، يُعاملها كما يعامل طفلٌ لعبته: يقذفها، يرميها، يهملها، ثم يبحث عن بديلة. هذا التصوّر الطفولي الظالم يُخالف جوهر الإسلام، الذي كرّم المرأة، ومنحها حقوقها، وفرض لها مكانةً كريمة، لا تقلّ عن مكانة الرجل، رغم أنفك أيها الولدُ المشاكس!
لقد حفظ لنا الشعرُ العربي قصصَ حبٍّ لا تُنسى، وقد تشبّب الشعراء بحبيباتهم في مرحلة ما قبل الزواج. لكن من النادر أن نجد من ينظم الشعرَ في زوجته وهي حيّة، رغم أنهم لم يبخلوا في الرثاء، حين يصرّحون بأوجاعهم بعد فوات الأوان. ولم يكن نزار قباني استثناءً، حين رثى زوجته الشهيدة بلقيس، فقال:
بلقيس.. يا وجعي
ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل
هل يا تُرى..
من بعد شعركِ سوف ترتفع السنابل؟
ذلك الحب الذي لا يكتفي بمشاركة الحياة، بل يقاوم الغياب، هو ما يمنح العلاقات معناها الأعمق.
فعند الفقد، يتحوّل الاكتشاف المشترك إلى رباطٍ يتجاوز الزمن، ويسكن الذاكرة.
وحده العشق الذي يواجه الموت كبداية لا كنهاية، يكشف لنا البعد الميتافيزيقي للحب.
لقد ذكرت الميثولوجيا اليونانية من غامر بالذهاب إلى ديار الموت لاسترداد محبوبته، وهذا ما ينافي الواقع الذي خبرناه، فترانا نلوذ بالحلم ونبحث في دهاليزه، علّنا نلتقي بالحبيب المفقود.
ومن الناس من يأتيك باكيًا، يقول: “رأيت زوجتي ليلة الأمس في المنام، وقد أوصتني أن لا أبقى وحيدًا، بل أن أتزوج.”
ربما في ذلك ما يكشف عن توق الإنسان الفطري للحياة، ورغبته في أن يرقص تحت المطر حتى يبرز قوس قزح وتبدو له الحقيقة.
وهكذا، يظل الاكتشاف المشترك قائمًا حتى بعد الرحيل، حين يتحوّل الحضور إلى أثر، والحب إلى معنى يسكن الذاكرة ويحرس الغياب.
المحور الرابع: التحديات المعاصرة – كيف نُعيد تعريف الزواج؟
لم يَعُد الزواج في زمننا مجرّد عقدٍ اجتماعي كما تصوغه العادات، ولا مشروعًا فرديًا كما تراه النزعات الحديثة، بل غدا ميدانًا تتقاطع فيه ضغوطٌ اقتصادية وثقافية ونفسية، تهدّد جوهره ومعناه. فمع تسلّل النظرة النفعية إلى العلاقات، بات الزواج يُقارب كصفقةٍ مالية تُحسب فيها الأرباح والخسائر، بينما هو في أصله التزامٌ وجداني، يقوم على النيّة الصادقة، والجهد المشترك، والعطاء المستمر.
تفاقمت التحديات مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، ما دفع بعضَ الشباب إلى البحث عن بدائلَ كـ”المساكنة” خارج إطار الزواج الشرعي، هربًا من القيود، دون اعتبار لما تحمله هذه الخيارات من تفككٍ اجتماعي وأخلاقي.
وفي هذا السياق المضطرب، برزت دعواتٌ وافدة تُعيد تعريف الزواج بشكلٍ يتعارض مع منظومتنا القِيَمية، ومنها تطبيعُ مفهوم الزواج المثلي بوصفه رمزًا للحرية والتقدم. هذه الدعوات لا تقف عند حدّ التعبير عن اختلاف، بل تسعى إلى فرض تصوّراتٍ دخيلة تزعزع ثوابت الأسرة، وتُربك وعي الأجيال الناشئة بمعاني الارتباط والهوية، مما يُهدّد النسيج الاجتماعي في عمقه.
وبين جمود التقاليد وتسيّب الحداثة، يحاول الجيلُ الجديد شقّ طريقٍ ثالث، يجمع بين الأصالة والوعي، ويُعيد إحياء القيم برؤيةٍ معاصرة تُراعي التغيّرات دون أن تُفرّط في الجوهر. فالعلاقة الزوجية، في صورتها المتوازنة، لا تزال مدرسةً للتكامل والنمو، تُبنى لا على القوالب الجاهزة، بل على التصميم المشترك، وعلى الحرية التي لا تُلغي الانتماء، بل تعمقها
الخاتمة:
في النهاية، ليس الاكتشاف المشترك لحظة وصول، بل نمط عيش. نكتشف لنعيش، ونعيش لنكتشف، في دورة لا تنتهي من التعجّب والتعلّق، من الفهم والتسامح، من الإصغاء والتغيّر. فالعلاقة ليست حلاً لألغازنا، بل مرايا تعكسها برفق، وتدعونا للتأمل فيها معًا. وفي رفقةٍ تبدأ بالصداقة وتتوج بالزواج، نختبر كيف يصبح العيشُ مغامرةً يومية في اكتشاف الآخر، وذاتنا معه.
سعيد ذياب سليم