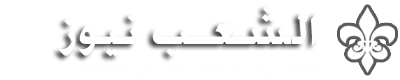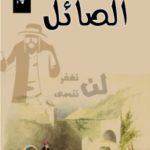آليات التمهيد للاحتلال في رواية “الصائل” لمحمد سرسك بقلم: أُسيد الحوتري
الشعب نيوز:-
تكشف رواية الصائل للكاتب الفلسطيني محمد سرسك عن طبقات سردية تتجاوز التوثيق المباشر لوقائع الاحتلال الصهيوني، لتغوص في الجذور العميقة والآليات الناعمة التي مهّدت له الطريق. فالمحتل لا يدخل مشهد الأرض بوصفه قوة عسكرية طاغية فحسب، بل يظهر أولًا كفاعل اقتصادي، وكحليف موهوم، وكصاحب خطاب ديني–ثقافي مراوغ. ومن هذا المنظور، توضح الرواية ما يسميه النقد ما بعد الكولونيالي بـ”آليات التهيئة للاستعمار” وهي البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والرمزية التي تُعبّد الطريق أمام المشروع الكولونيالي قبل أن يُعلن عن نفسه بصيغته العنيفة وبوجهه القبيح.
تكشف الرواية عن أوجه الهيمنة الاقتصادية بوصفها إحدى آليات الاستعمار الناعمة التي تسعى إلى تطويع السكان المحليين وإعادة تشكيل وعيهم ومصيرهم وفق مصالح المحتل، حيث يتجلى ذلك أولاً في تقديم “أبي إسحق” نفسه كمنقذ زراعي للفلاحين، مستغلًا هشاشتهم الاقتصادية وحاجتهم إلى أدوات الإنتاج الحديثة، إذ “إنهم ينتظرون منه المساعدة، لقد وعدهم أبو إسحاق بتراكتور زراعي…” (66). لكن هذا “المنقذ” لم يأتِ مجانًا، بل سرعان ما تحوّل إلى بنك ربوي يستنزف القرية عبر نظام دَين مغلّف بوعود خادعة، فحين عجز المختار عن تسديد الضرائب، اقترض مئتي جنيه، لكن أبا إسحاق “راح يكتب السند بثلاثمئة ليرة لأنه السداد بعد سنتين” (89)، في ممارسة توضح كيفية استغلال الزمن بوصفه أداة استعمارية تؤجل الانهيار لكنها تضاعف تبعاته. وتكشفت الصورة أكثر حين أضحى “بعض من الرجال قد استدان سرا من أبي إسحاق…لتصريف شؤون حياتهم…لم يكن ذلك ترفًا عارضًا في أغلب الأحيان” (118)، فالعوز لا يتيح لهم رفاهية الرفض أو التفكير خارج الحاجات اليومية، “الحاجة والعوز هي ما يحركهم، ولا يخطر في أذهانهم كل الأفكار التي يحملها الشباب” (182)، وهكذا وقع “نصف أهل قريته مدينون لأبي إسحاق، والنصف الآخر يعمل عنده” (132)، لتكتمل دائرة التبعية والاحتواء.
ولا تكتفي الرواية برصد الدور الربوي للمحتل، بل تفضح أيضًا تمظهراته كمستثمر انتهازي يشتري الأرض بأسعار مرتفعة لإقناع الفلاحين بالبيع الطوعي، فتُحذف الحدود الرمزية بين الوطن والسلعة، كما في قوله: “هل يمكن إعطائي قطعة صغيرة من الأرض حتى أقيم لي بيتًا صغيرًا قبل رحيلي؟… أنا جاهز لدفع الثمن مهما بلغ” (21–23). وفي خطوة مكمّلة، يتحول الفلاحون من ملاك أرض إلى أُجراء، ما يشي بإعادة إنتاج البنية الطبقية داخل المنظومة الاستعمارية ذاتها، “أصبح معظم الفلاحين في القرية أُجراء في مزارع الخواجا…” (100)، ويتضاعف هذا الأثر حين يوظف أبو إسحاق رموزًا محلية لتجميل صورته الخادعة، كما فعل مع “عطية” الذي تحوّل إلى دمية تنفيذية، يتلقى ما يغدقه عليه أبو إسحاق من نِعم، فيسدد ديون الآخرين، ويتزوج قسرًا، ليصبح رمزًا للتواطؤ المحلي مع السلطة الغازية. وبهذه الآليات المتشابكة، لا يعود للفلاح قرار مستقل، إذ “أصبح يتحكم [أبو إسحاق] في أفعالهم وردود أفعالهم وقراراتهم…فهم يعتمدون عليه في معيشتهم وقضاء حاجاتهم” (121)، وهو ما يتوّج مشهد الهيمنة الاقتصادية بصيغته الأكثر تعقيدًا وخطورة، حيث تسود السيطرة بلا سلاح، ويُستبدل العنف المادي بالتطويع الرمزي والمؤسسي، فتغدو القرية صورة مصغرة عن مشروع كولونيالي أشمل.
وفي هذا السياق، تلعب الرواية على مفارقة بالغة الدقة: فالمحتل، وهو يتقدّم ناعمًا من بوابة الاقتصاد، يعيد تشكيل بنية السلطة المحلية. فهو يتقرب من المختار ووجهاء القرية، ويقيم مجالسه الموازية:”أقام في داره مجلسًا كبيرًا، يضاهي مجلس المختار…” (161)، مستغلاً الفراغ السياسي الناتج عن تآكل السلطة العثمانية” :الجبهات المفتوحة للجيش، خصوصا حروب البلقان مع روسيا القيصرية… نظام الامتيازات الأجنبية التي فرضتها الدول الأوروبية على الدولة العثمانية” (111)، ومستغلاً ضعف الدولة التي فقدت كثيرا من أراضيها، فقد “تطاولت فرنسا وبريطانيا على الدولة العثمانية، وسيطروا على أجزاء منها…” (108).
وإلى جانب الاقتصاد والسلطة، تشتغل الرواية على تفكيك الهوية الثقافية والدينية، من خلال قناع “المحلّي” الذي يتقنه أبو إسحاق، إذ يتخفّى خلف هيئة محبوبة ومتواضعة، تُجنّبه الرفض الاجتماعي والسياسي، ويمنح أدواته ،كما في حالة عطية، سلطة رمزية وسلاحًا: “رحل وترك خيمته وبندقيته لعطية الذي أصبح يتجوّل بها مزهوًا…” (40).
ولأن الكولونيالية لا تكتفي بتثبيت حضورها، بل تعمل على إنتاج شرعيتها، فإن أبو إسحاق يسعى إلى صناعة سردية دينية توراتية زائفة، تُضفي على وجوده مسحة “قداسة”، كما في محاولته نسبة ضريح إسلامي إلى نبي يهودي مجهول :”قد يكون لأحد أنبيائنا، فهو ليس من مئة سنة كما تقول، بل من ألفي سنة أو أكثر” (95)، ويؤكد هذا أحد الفلاحين: “يقول الخواجا [أبو إسحاق] أن قبر سيدنا هو قبر مقدس عندهم… يقول إنه لأحد أنبيائهم غير المعروفين…” (121).
تُضاف إلى ذلك سياسة محو الآثار المادية للهوية الفلسطينية، كما في استهداف الشجرة المباركة، رمز الاستمرارية، والعطاء، والوفرة، والقداسة، إذ يُوعز أبو إسحق إلى عطية أن يسكب مادة قاتلة حول جذعها، “ويخلط المحلول في الماء في دلو كبير ثم يحمله ليسكبه حول جذع الشجرة” (149).
أما على المستوى السياسي الدولي، فتكشف الرواية كيف يحتمي المشروع الصهيوني بالقوى الغربية ويحظى بالرعاية البريطانية، ويخفي نواياه الاستيطانية خلف اتفاقيات ومساعدات مريبة: “هل سمعتم بوعد بلفور؟…إنه وعد من بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين” (172)، , وتطوَّر الوعد ليصبح حقيقة، “مع دخول القوات البريطانية إلى فلسطين، وبدون أن تثير بريطانيا أي انتباه، أدخلت معها فيلقًا يهوديًا بكامل سلاحه وعتاده، والذي دخل هناك ليبقى” (170).
في هذا السياق، لا تفوّت الرواية الإشارة إلى الهجرة الصهيونية المنظمة من روسيا ورومانيا، التي رافقت مرحلة التمهيد وأُشبعت غطاءً قانونيًا، وهؤلاء المهاجرين جاءوا ليبقوا: “فهجرة اليهود لم تتوقف ولو بأعداد قليلة… كانوا يأتون من روسيا ورومانيا” (137).
وتختم الرواية هذا المخطط المركب بأهم أدوات الاستعمار: خلق قيادات بديلة تكون مطواعة وخادمة للمحتل، كما في شخصية “عطية” الذي يصبح له مجلسه الخاص ووجاهته الاقتصادية: “زادت ثروته ووسع داره، وأقام فيها مجلسًا كبيرًا، يضاهي مجلس المختار…” (160). ثم تبزغ المستعمرات أخيرًا بوصفها الذروة البنيوية لكل ما سبق، وهي المقرات التي سينطلق منها الاحتلال ليظهر في أبشع صوره، “وعن مستعمراتهم التي كانت تنتشر ببطء في أرجاء فلسطين” (171).
في المحصلة، لا تُعنى “الصائل “برصد الاحتلال كحدث، بل بتفكيك البنية التي جعلت هذا الحدث ممكنًا، وأرسته على قواعد من التواطؤ الداخلي، والانسحاق الاجتماعي، والغياب السياسي. وهي بهذا تقدم نموذجًا روائيًا لما بعد الكولونيالية: كشف البنية العميقة للاحتلال، التي لا تبدأ بالبندقية، بل بالقرض، والضيافة، والضريح، والحكاية.إنها رواية توعوية بامتياز، تُذكّر القارئ بأن الاحتلال لا يبدأ كصوت مدويّ فحسب، بل يبدأ همسًا، وأن الصائل لا تنتهي صولته إلا وقد هتك العرض وسرق الأرض والذاكرة معًا.