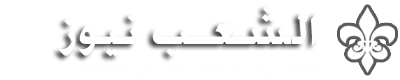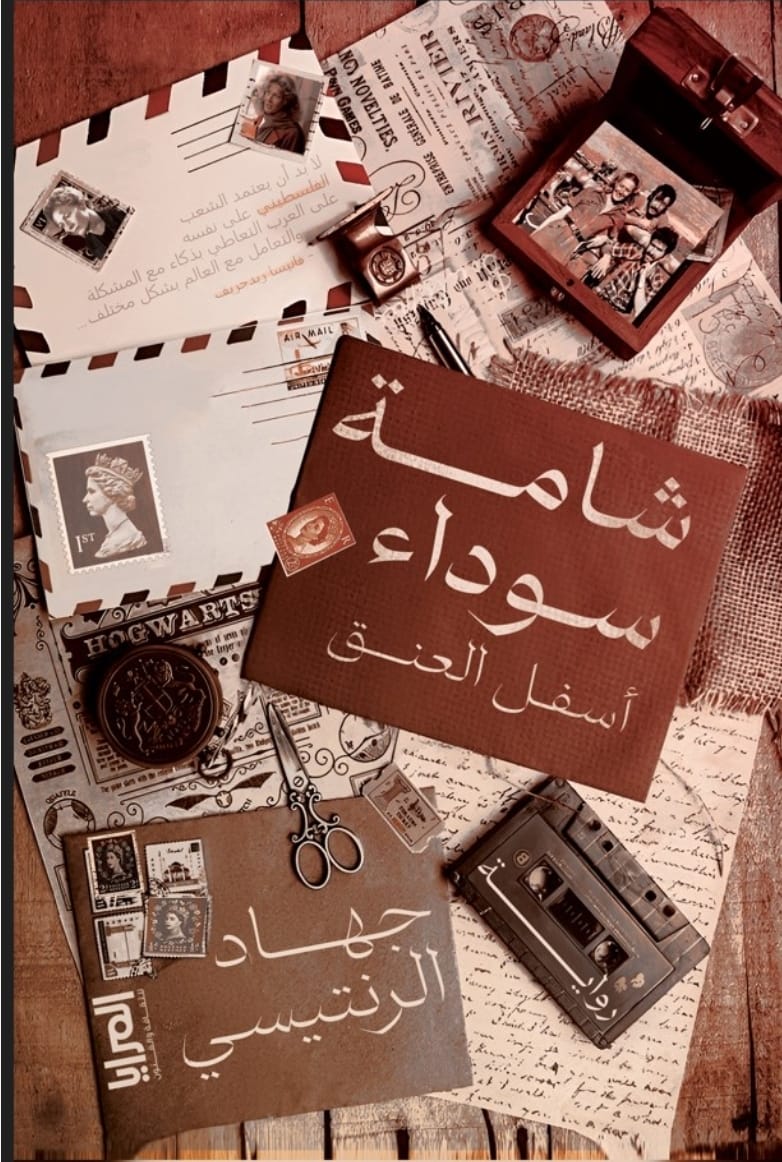شامة سوداء أسفل العنق” لجهاد الرنتيسي: رواية التساؤلات وغياب المسلَّمات قراءة: أُسَيْد الحوتري
الشعب نيوز:-
لم يعد اليقين مطلبًا في النص الأدبي منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وظهور مدرسة الحداثة في القرن العشرين. فالكاتب الحداثي لم يعد ملزَمًا بتقديم حلول أو رسائل منجَزة، بل غدت مهمته كشف المسائل وفتح الأسئلة للتأمل والاشتباك.
في هذا السياق، تأتي رواية “شامة سوداء أسفل العنق ” للروائي جهاد الرنتيسي كمثال ساطع على نص يتقصَّد الغموض، ويعتني بالشك، ويرفض اليقينات المسبقة أو النهايات الحاسمة. في هذا العالم السردي المتشظِّي، لا شيء يثبت على وضوح، ولا ينجو أحد من سطوة الاحتمال والتساؤل. ويؤكد الرنتيسي هاجس الأسئلة التي لا إجابات لها، فيقول: “فَتَحَ الحوار مع أماني طاقة لأسئلة عجز عن الإجابة عنها” (75).
في هذه الرواية، يرسم الرنتيسي خريطة ضبابية غامضة ومتشظية للهوية الفلسطينية، تتوزع بين جغرافيا المنفى وتناقضات الانتماء، ويكشف من خلالها عن تحولات الفلسطيني بين زمنين ومكانين، الكويت وخارجها، كما يعرِّي الصورة البطولية النمطية التي طالما رافقت السردية الوطنية.
الفلسطيني في الكويت يظهر ككائن معلَّق بين الاقتلاع والاستقرار، مجرد عامل أو لاجئ مؤقَّت يدفع المال من أجل الإقامة أو حتى الزيارة، إذ يقول السارد: “تجاهل إلحاح أبيه على عودته إلى الكويت بعد صدور تصريح الزيارة، دفعت خمسمئة دينار للكفيل، قال له في أحد اتصالاته، وعدوني بتصريح الإقامة فور عودتك” (77). هذه الهوية لا تُبنى على واقع، بل على ذكرى خائفة، وتُختزل بمفردات اللجوء والمنفى، حيث تحل الإقامة أو تصريح العمل محلّ الوطن، والمؤقَّت محل الدائم.
أما خارج الكويت، فتظهر الشخصية الفلسطينية المتعبة، التي هجرت المقاومة أو صمتت عنها، كما يرد على لسان السارد: “اللقاء الأول مع الحسن حافل بالمفاجآت، شدّته العبارة لحديث الكاهن، لم يجد في حديثه ما يوحي بمعاداة أميركا… لولا دعمها غير المشروط لإسرائيل… كان يتوقع سماع شيء عن الإمبريالية والتناقض الطبقي وخرج بخُفّي حنين” (39). وهذا تجلٍّ لتراجع واضح عن الدور المقاوم التقليدي الذي يعادي كل أشكال الهيمنة والاستعمار.
وإلى جانب هذه الصورة الباهتة، تظهر شخصية “بطل” الرواية، يدخن ويحشّش ويسكر هربًا من قضايا الوطن أحيانًا، وتلبيةً لأوامر الوطنيين أحيانًا أخرى !”جاءته بكأس ويسكي من بقايا الليلة الفائتة، تكفي رشفة واحدة لتتخلص من صداعك، ارتشف رشفتين دونما تفكير” (10). ومن الـ”ويسكي” إلى سيجارة الحشيش المشتركة، ينتقل “البطل” بكل وقار لينسى الهزيمة: “عرف ليلتها تدخين الحشيشة، أخرجت سيجارة من العلبة، بقايا ما جاء به رمزي من البقاع، قالت قبل إشعالها، نفس لي وآخر لك لننسى هزيمة الأصدقاء” (32).
كما قُدِّمت شخصية الفلسطيني أحيانًا بصورة شهوانية، زير نساء، في تفكيك متعمَّد لصورة “المناضل الطاهر” التي غالبًا ما روَّجت لها الخطابات القومية. أحد أبرز هذه التجليات يظهر في علاقة البطل بامرأة متزوجة، هي “أم عامر”، إذ يقول السارد: “كانت ليلة مختلفة مع أم عامر، يسحب نفسًا من سيجارة [ماركة] الحمراء، كل ليلة من لياليها مختلفة عن الأخرى، ينفث ما في صدره من دخان، أضيف تحدٍّ آخر لتحدي الإرواء في الليالي التالية لتلك الليلة، كان ينقلها إلى عالم آخر، صار يحاول تخليصها من ثقل أسرارها” (34)، وهنا تظهر “بطولة” من نوع آخر، حيث تُبنى مهمة تخليص أم عامر من ثقل أسرار ترزح تحتها!
ظلت الضبابية تكتنف هوية الفلسطيني في الرواية، وتأرجحت صورته بين لوني الخير والشر، في غموض متعمَّد يصوِّر واقعًا مريرًا، دون أن يحاول تسويق بضاعة مثالية لا وجود لها.
تتوسع حلقة الغموض حين يُكلَّف الراوي بالاقتراب من دائرة أم عامر، ولكن لم يُقَل له بصراحة ما هو مطلوب منه. يقول سعد الخبايا: “طلبنا منك الاقتراب من دائرة أم عامر لنطّلع على ما يدور هناك، مفاجأة أخرى، لم نطلب الانغماس في عوالمها” (22). تبدو المهمة كأنها مرآة يعلوها الضباب، لا تعكس سوى ظلال، فلا ندري ماهوالمطلوب على وجه الدقة! أهو رصد؟ أم استدراج؟ أم اختبار؟ الأكيد أنه سيخرج من تلك المهمة كما دخلها: مغلَّفًا بالريبة، متشظّي الأفكار، دون تحقيق هدف واضح.
على المسار عينه، تتجلّى علاقته بأم عامر، وهي علاقة تمتزج فيها الشهوة بالتساؤل، والقرب بالشك.فلا هو عاشق ولا هو مُخبر، ولا هي ضحية ولا هي صانعة للفخ. يقول السارد واصفًا ليلتهما: “وجدها عالمًا من الظمأ في تلك الليلة، صارت له عشيقات… أحسّ بهشاشتها، التصقت به” (72). جسدان يتجاوران في العتمة، وعقلان يتبادلان الصمت أكثر مما يتبادلان الكلام. علاقتهما تجسيد حيٌّ لعلاقة الفلسطيني المنفي مع ذاته: علاقة باردة، مشتهاة، مشكوك فيها. وهل كانت أم عامر مناضلة حقًّا؟ أم مجرد صورة عن النسوية السياسية؟
أما (فانيسيا ريدغريف)، فشخصية غامضة، تراوح بين الحقيقة والخيال، تقف بين الحضور والغياب، بين الرسالة والسراب. تمثل بذاتها وغيابها وحواضرها ورسائلها كيانًا مشوَّشًا يترك أبواب التأويل مشرعة على مصاريعها.
لا نعرف أكانت صادقة أم ممثلة أخرى في مسرح السياسة، ولا نعلم إن كان بينها وبين الراوي ما هو أعمق من التعاطف. في أحد مواضع السرد، يترك الكاتب السؤال معلَّقًا بقوله: “فانيسيا هاربة من رواية تبحث عمن يكتبها… من يكتب روايتها؟ بقي السؤال معلقًا” (61). النص لا يجيب، ولا يعترف، ولا ينفي، بل يترك القارئ معلَّقًا على حافة الاحتمال. رغم مراسلاتها المتكررة، تختفي في النهاية بشكل مبهم. هل ابتعدت بسبب خيبة؟ هل انسحبت من المشهد بفعل ضغوط سياسية؟ أسئلة تنتظر الإجابة.
يطرح عنوان الرواية “شامة سوداء أسفل العنق” مجموعة من التساؤلات. فما المعنى الذي تحمله؟ هل هي شامة جمانة السوداء؟ أهي مجرد علامة جسدية أم توقيع على جسد الذاكرة؟ يقول السارد واصفًا تلك اللحظة: “أطالت النظر في عينيه، أتاح قربه منها رؤية شامة سوداء أسفل عنقها” (43). هل هي معنى مطمور في طيات الروح؟ توقّع لا يتحقق؟ إشارة لما لا يُقال؟ هل هي إشارة إلى التجذُّر الفلسطيني؟ إلى العلامة التي نبحث عنها في كل أحد؟ أم إلى اللعنة التي أربكت الفلسطيني وخلطت له كل أوراقه؟ المعنى يتعدّد دون حسم.
وتنضم الأسئلة لتطال مصير ماجد أبو شرار وتفاصيل اغتياله الغامض، الذي تلمّح الرواية إلى أن بعض أصابع الداخل قد تكون تواطأت في غيابه القاسي. تقول الرواية عن مشهد جانبي محمَّل بالدلالة: “بعد عرض فيلم الفلسطيني في قاعة ماجد أبو شرار، حدثته أم عامر خلال جلوسهما في شرفتها ذات مساء عن تندر البدينات على طول قامتها، قلّلت من أهمية إشادة بعضهن بخصرها، سخرت من محاولة النحيفات التشبه بقوامها” (74). ولكن كما في كل ما سبق، لا يُقال شيءٌ على نحو حاسم عن اغتيال أبو شرار. الحقيقة تذوب في السخرية، والبطولة تُمسخ في أحاديث جانبية عن اسم قاعة أو وصف جسد أم عامر. كل شيء يتحوّل إلى ما يشبه المزاح الأسود السمج، وكل ذاكرة تتآكل تحت وطأة التناسي، لا النسيان.
بعد ذلك، نعود إلى جواد الديك، ذلك الكائن المتشظّي بين المنافي، الذي نجهل إن كان قد بقي في التنظيم أم خرج، إن كان انكسر أم انسحب، إن كان يحب أم يهرب. يتحدث التنظيم عنه قائلًا: “استنزفتك سهرات اللهو مع الفنانين، علت نبرة الصوت، قررنا إعفاءك من المهمة، وافق دون نقاش” (22). لا نعرف إن كان جواد لا يزال يحلم بفلسطين، أم أنه بات يحلم بالخلاص من الحلم ذاته. في الرواية، يظهر جواد ناقمًا وناقدًا، لكنه لا يصرِّح بموقف قاطع. هل استقال؟ أم طُرد؟ أم انسحب روحيًّا وبقي شكليًّا؟
تتسم الرواية أيضًا بغموض زمني ومكاني يترك القارئ في حالة من الترقب والبحث، إذ تتنقّل الأحداث بين مدن عدة مثل الكويت وبيروت ودمشق وعمان وتونس، من دون أن تُقدَّم تواريخ دقيقة أو تسلسل زمني واضح.
فلا يُعرف ما إذا كانت الوقائع تجري في عام محدد، ولا يُرشد النص القارئ إلى خطٍّ زمنيٍّ صريح، بل يُترك له حرية اكتشاف ذلك بنفسه، مما يضفي طابعًا تأمليًّا ويعزز من التفاعل مع النص بوصفه لغزًا سرديًّا يتطلب القراءة المتأنية والتفكيك.
في الرواية إذن، تتراكم اللامؤكدات: ملامح الهوية الفلسطينية، هدف مهمة التقرب من أم عامر، طبيعة العلاقة معها، نهاية فانيسيا، موقف جواد من التنظيم، معنى الشامة السوداء، مصير ماجد أبو شرار، غموض الزمكانية، والكثير مما لا مجال لحصره.كلها مفاتيح متاهة يصر الكاتب على أن يترك أبوابها مشرعة لا تُغلق، ونوافذها مفتوحة لا تُسدّ. هذا ليس ضعفًا في البناء، بل فلسفة في الكتابة، واختيار واعٍ لشكل من أشكال السرد يرفض تطويب النص، بل يمنح القارئ مسؤولية الإدراك.
لعلّ الحكمة التي تحكم هذا النص تقول: في زمن الحروب والانهيارات، لا تُروى الحكاية لتُفهم، بل لتُعاش من جديد… على هيئة مجموعة من التساؤلات واللامؤكدات.