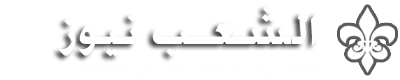“أحلام ممنوعة” : “همسات خلف الأبواب الموصدة” تبارك الياسين تحاور الكاتب محمد رمضان الجبور
الشعب نيوز:-
في “أحلام ممنوعة”، يأخذنا محمد رمضان الجبور في رحلة أدبية عبر زوايا النفس البشرية وشقوق المجتمع، حيث تتشابك الأحلام المكبوتة مع الواقع القاسي. هذه المجموعة القصصية القصيرة جداً ليست مجرد حكايات، بل هي نبضات مكثفة تلتقط لحظات من الألم، الفقدان، والتوق إلى ما هو محرم أو مستحيل. بأسلوبه الموجز والبليغ، ينسج الجبور لوحات سردية تكشف عن هموم الإنسان العربي، من الفقر إلى الهجرة، ومن الحنين إلى المواجهة مع الحواجز الاجتماعية. كل قصة هي نافذة صغيرة تطل على عالم واسع من الصراعات الداخلية والخارجية، حيث تتحول الأحلام إلى أسئلة مؤرقة: ماذا يحدث عندما يُمنع الحلم؟ وكيف يصنع الإنسان مصيره في ظل القيود؟ “أحلام ممنوعة” دعوة للتأمل في الإنسانية المعلقة بين الرغبة والواقع، وصرخة أدبية تتردد صداها في القلب والضمير
1 ـ يستخدم محمد رمضان الجبور القصة القصيرة جداً كأداة فنية لنقل قضايا اجتماعية معقدة، فهل ينجح في تحقيق العمق رغم قصر النصوص؟
ج ـ في «أحلام ممنوعة» يتجلّى المعنى في لحظة البرق، فكأنها كتابة بالنور لا بالحبر، فالقِصَر ليس ضيقًا، بل هو كثافة وجودٍ تتقاطع فيها التجربة الإنسانية مع الوعي الاجتماعي في نقطةٍ خاطفة. فكل قصة قصيرة جداً في المجموعة تُشبه ومضةً في ليلٍ طويل؛ لكنها ومضة تُضيء فضاء الإنسان المقموع بأحلامه وأوجاعه. وأشعر في تحقيق العمق لأن النص لا يتكئ على السرد بل على الانفجار الدلالي، فالكلمة الواحدة تحمل شحنة مجتمعٍ كامل، والنهاية الومضية تُفتح كنافذة على عوالم محرَّمة من الحرية والكرامة والرجاء. في هذا الاقتصاد التعبيري تتحقق المعادلة الصعبة: نصوص قصيرة بمدى إنساني فسيح، ومشاهد وجيزة تترك ظلالًا لا تزول، ؛ فكل قصة هي لحظة تفجّرٍ داخلي تختصر حياة بأكملها. العمق هنا ليس في الطول، بل في انكسار الضوء بين حرفٍ وحرف. وهكذا فالقصة القصيرة جدًا فضاءً للدهشة، ومجهرًا يعرّي البنية النفسية والاجتماعية للإنسان العربي، حيث كل ومضة تحمل ظلال مدينةٍ كاملة من الخيبة والأمل المؤجّل.
2 ـ ما هي الأساليب اللغوية أو البلاغية في “أحلام ممنوعة” التي تعزز من تأثير القصص على القارئ، مثل الاستعارات أو التكثيف الدرامي؟
ج ـ لغة «أحلام ممنوعة» مشغولة بالنار لا بالزخرف. إنها لغة تشعل ولا تزيّن، فتوظيف الاستعارة بوصفها فعلَ مقاومةٍ جماليّة يحوّل الأشياء اليومية إلى رموز حية: الجدار إلى صمت، والنافذة إلى خلاص مؤجل، والظل إلى كائنٍ خائفٍ من الضوء. الاعتماد على التكثيف الدرامي يضغط اللحظة حتى تصرخ، وعلى المفارقة التي تُسقط القارئ في دهشةٍ موجعة. الجملة في معظم النصوص لا تتنفس إلا بالاختناق المقصود، فكل فاصلة هي انقطاع نَفَس، وكل نقطة سقوط حلم. في لغةٍ تتجاور البلاغة والسكين، ويتحوّل الإيجاز إلى صرخةٍ مجروحةٍ بالحقيقة، ليصبح النص قطعةً من شعرٍ نُزِع من قلب الواقع.
واستخدام التوازي الإيقاعي كنبضٍ درامي يجعل النص يتأرجح بين الصمت والانفجار، فالتكثيف ليس اختصارًا بل ضغطٌ للوجع في مساحةٍ من الهواء. بهذه اللغة التي تمزج بين الشعر والجرح، يصبح أسلوبًا فريدًا يفتح الدلالة بقدر ما يُوجعها، فيتحوّل كل نص إلى شظية من مرآة الواقع
3 ـ كيف يعكس الكتاب التوتر بين الفرد والمجتمع في سياق القضايا المطروحة، مثل الهجرة أو الحرمان، وهل هناك رؤية نقدية واضحة للواقع؟
ج ـ التوتر بين الفرد والمجتمع في «أحلام ممنوعة» يشبه خيطًا مشدودًا بين جناحين لا يستطيعان الطيران معًا. فالفرد في النصوص لا يتمرّد فقط على القيد الاجتماعي، بل يحاول أن يفهم أسباب وجوده في عالمٍ يحرمه من الحلم والكرامة. المجتمع في هذه القصص ليس جدارًا خارجيًا فحسب، بل هو ظلٌّ يسكن الذات، يلاحقها أينما ذهبت. من هنا تأتي الرؤية النقدية الواضحة: فالنصوص لا تكتفي بوصف الألم، بل بوضع الاصبع على الجرح البنيوي في الوعي الجمعي، حيث يتحوّل الامتثال إلى عبودية، والحلم إلى جريمة. وهكذا يصبح النصّ ساحة صراعٍ بين الإنسان والمصير، بين الحلم الممنوع والواقع الذي يحرس المنع بصلابةٍ باردة.
4 ـ هل يمكن اعتبار “أحلام ممنوعة” عملاً ينتمي إلى الأدب الواقعي أم أن هناك عناصر رمزية أو سريالية تسيطر على النصوص؟
ج ـ «أحلام ممنوعة» ليست واقعية بمعناها الكلاسيكي، بل هي واقعية تنزف في مرآة الرمز، لا أصف العالم كما هو، بل كما يُحَسّ في أعماق المقموعين. لذلك تتسلل الرمزية إلى قلب المشهد دون أن تفقده صدقه الاجتماعي. الشخصيات والأشياء تتحول إلى إشاراتٍ تتجاوز الملموس لتلامس المجازي؛ فالأحلام ليست مجرد وقائع، بل استعارات كبرى للحرية والكرامة والوجود. وحتى حين تلوح السريالية في بعض المقاطع، فإنها ليست هروبًا من الواقع بل إدانةً له، كأن الحلم صار الشكل الأخير من أشكال الاحتجاج. بذلك يتم خلق لغةً جديدة للواقعية: واقعيةً تكتب بمداد الحلم الممنوع.
5 ـ كيف تساهم بنية القصص القصيرة جداً في الكتاب في خلق إحساس بالإلحاح أو الضغط النفسي لدى القارئ؟
ج ـ البنية القصيرة جداً في «أحلام ممنوعة» تعمل مثل قنبلة زمنية لغوية، انفجارها لحظيّ لكن صداها طويل. كل قصة تُبنى على توترٍ متصاعد ينتهي بانقطاعٍ حاد، فتترك القارئ في منطقة الترقب والاختناق. هذا الإيجاز لا يمنح القارئ فرصةً لالتقاط أنفاسه؛ إنه يدفعه دفعًا نحو الحافة، ليعيش التوتر ذاته الذي يعيشه أبطال النصوص. من هنا يتولّد الإحساس بالضغط النفسي، فكل كلمة تحمل وزن العالم، وكل صمتٍ داخل النص هو صرخةٌ مؤجلة. بهذه التقنية يتحقق وظيفة الومضة: أن تُصيب القارئ بصدمةٍ جماليةٍ وفكريةٍ في آن، دون أن تمنحه مهربًا من الأسئلة التي تشتعل بعد القراءة.
6 ـ ما مدى نجاح الكاتب في تقديم شخصيات متعددة الأبعاد ضمن قيود القصة القصيرة جداً، وهل هناك أمثلة بارزة على ذلك؟
ج ـ برغم ضيق المساحة، تنبض شخصيات «أحلام ممنوعة» بعمقٍ إنساني لافت. إنها شخصيات محفورة بالسكين لا بالريشة؛ يظهر القليل منها ليُحيل إلى الكثير. في بضع جملٍ تتكشّف مصائر كاملة، وتُبنى حياة بأكملها على نظرةٍ أو فعلٍ أو صمتٍ واحد. فالقصص والنصوص لا تصف الشخصيات بل يتم تركها تُفصح عن ذاتها بالفعل أو الهزيمة أو الحلم. وهي غالبًا شخصيات مأزومة، تمشي على الحدّ الفاصل بين الأمل والانكسار، تمثّل الإنسان العربي في قلقه وتردده بين الخضوع والمقاومة. ونجاح الكاتب في رسم أبعادها يعود إلى قدرته على التلميح بدل التصريح، وعلى تحويل اللمحة إلى مرآةٍ كاشفةٍ للروح.

7 ـ كيف يعالج الكتاب مفهوم “المنع” في الأحلام، وهل يقدم تفسيراً فلسفياً أم اجتماعياً لهذا المنع؟
ج ـ المنع في «أحلام ممنوعة» ليس جدارًا خارجيًا فحسب، بل هو حالة وجودية يعيشها الإنسان في عالمٍ ينكر عليه حقّه في الحلم. المنع هنا يتجاوز السياسة والاجتماع ليصبح سؤالًا فلسفيًا عن الحرية ذاتها: لماذا نحلم إذا كان الحلم جريمة؟ الكاتب يقرأ المنع بوصفه آلية قمعٍ متغلغلة في الوعي، تبدأ من الطفولة ولا تنتهي عند السلطة. الأحلام المحظورة ليست إلا رمزًا للرغبات الموءودة، وللأصوات التي خُنقت باسم النظام والعرف والقدر. بهذا المعنى، يتم وضع تفسير مزدوج؛ اجتماعيّ في ظاهره، وفلسفيّ في عمقه، حيث يتحوّل المنع إلى مرآةٍ تكشف هشاشة الإنسان أمام سلطاتٍ متراكبة: سلطة المجتمع، وسلطة الخوف، وسلطة الذات.
8 ـ هل يمكن قراءة “أحلام ممنوعة” كعمل سياسي ضمني ينتقد الأوضاع الاجتماعية أو السياسية في السياق الأردني أو العربي؟
ج ـ نعم، ولكنها سياسة الحلم لا شعارات المنبر. فالقصص في معظمها تكتب السياسة عبر الإنسان، لا عبر الخطاب. نصوص تنزف من جرحٍ جمعي، وتهمس بما لا يُقال في الميادين. في كل قصة ظلّ احتجاجٍ على القهر، على البيروقراطية، على الغربة داخل الوطن، على اغتيال البراءة باسم “النظام”. غير أن احتجاجه ليس مباشرًا؛ بل هو صوتٌ خافت يحمل صدق الألم، يجعل القارئ يرى نفسه في مرآةٍ من الحبر الموجوع. وهكذا يتحول النص القصير إلى بيانٍ إنساني ضد الصمت، إلى شكلٍ من أشكال الوعي السياسي الجمالي الذي لا يرفع راية، لكنه يزرع بذرة سؤالٍ لا تموت.
9 ـ ما دور السرد المكثف في تعزيز الإحساس بالخسارة أو الحنين في قصص الكتاب، وهل هناك أمثلة محددة تدعم ذلك؟
ج ـ السرد المكثف في المجموعة هو موسيقى الحنين ذاتها. إنه اقتصاد لغوي ينبض بالفقد؛ فكل حذفٍ فيه هو ذاكرة، وكل بياضٍ على الصفحة هو قبر حلمٍ قديم. أسلوب السرد المتبع يجعل القارئ يشعر بأن الكلمات التي لم تُكتب هي الأشد حضورًا. الحنين لا يأتي من الصور وحدها، بل من الإيقاع الداخلي للجمل، من التوقفات الموحية، من الفراغات التي تتكلم أكثر من الحروف. الخسارة في نصوصه ليست حدثًا بل مناخًا، تُظلّل النصوص كلها بظلالها الرمادية، حتى يبدو القارئ كمن يسير في مدينةٍ من ذكرياتٍ مهدومةٍ على ضوء قمرٍ خافت. هذا هو سر تأثيرها: أن الحنين فيها ليس عاطفة، بل طقس من طقوس الكتابة.
10 ـ كيف يتعامل الكاتب مع التوازن بين اليأس والأمل في القصص، وهل يترك القارئ مع إحساس بالإمكانية أم بالإغلاق؟
ج ـ لا شك أن لا أمل بلا جرح، ولا يأس بلا شرفةٍ نحو الضوء. لذلك تتأرجح نصوص المجموعة على حدّ السكين بين العتمة والنور. فكل يأسٍ في «أحلام ممنوعة» يحمل في طيّاته احتمال الخلاص، وكل حلمٍ ممنوعٍ يضيء الطريق إلى حلمٍ آخر. النهاية المفتوحة في معظم القصص تترك القارئ معلّقًا بين الإغلاق والاحتمال، بين الموت والبعث، كأن تلك القصص والنصوص تريد أن تقول: حتى في المنع يولد المعنى الأمل ليس وعدًا، بل مقاومة صامتة ضد العدم، إصرار اللغة على أن تكتب رغم كل ما يُمنع عنها أن تقول. وهنا تكمن عظمة التوازن: أن يظل الحلم ممكنًا ولو في جملةٍ من رماد.
11 ـ هل يمكن اعتبار “أحلام ممنوعة” عملاً يعبر عن صوت جيل معين أو فئة اجتماعية معينة، أم أن موضوعاته عالمية؟
ج ـ إنها تجربة تبدأ من الجرح المحلي لتصل إلى الجرح الإنساني الكوني. صحيح أن تفاصيلها تتنفس من تربة الوطن والعالم العربي، لكنها تمسّ في جوهرها الإنسان في كل مكان؛ الإنسان الذي يُحاصر بالحلم والسلطة والذاكرة والانتظار. فالنصوص والقصص كتبت بلسان جيلٍ مأزومٍ بالأسئلة، لكنه يجعل من وجعه مرآةً للآخرين، فيصبح صوتًا لا يُحَدّ بجغرافيا. هذه النصوص تشبه وطنًا بلا حدود، وحلمًا لا يعترف بجواز السفر. ومن هنا تأتي عالميتها: إنها تكتب الإنسان كما هو، مكشوفًا أمام ذاته، محاصرًا بحلمه، ومنفيًّا في قلب لغته ، وارجو أن تجد من يترجمها لتصل خارج حدود الجغرافيا
العربية .
الاسم : محمد رمضان الجبور ( الصور باهري
مكان الولادة /عمان
العمل الحالي: .متقاعد
العمل سابقا: معلم ، مساعد مدير ، مدير مدرسة لأكثر من خمسة عشر عاما، مدير عام في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات
التحصيل العلمي: بكالوريوس لغة عربية الجامعة الأردنية .1997
دبلوم عالي إدارة مدرسية /الجامعة الهاشمية 2003
الهوية الأدبية : قاص وشاعر وناقد وكاتب للأطفال
عضو رابطة الكتّاب الأردنيين
عضو الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب
عضو اتحاد كتّاب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
عضو في التجمع الدولي لاتحادات الكتّاب
عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب
عضو في رابطة المبدعين العرب .
رئيس جمعية أبناء الرصيفة الثقافية .
الإصدارات الأدبية :
جدار الوهم 1987 ( مجموعة قصصية )
أبواب للدخول فقط 1994( مجموعة قصصية )
تعيش أنت 2007 ( مجموعة قصصية )
أحلام ممنوعة 2016( مجموعة قصصية )
أكاذيب المساء 2022( مجموعة قصصية )
حين تمرين في خاطري ( ديوان شعر) 2015
قراءات في عالم مصطفى القرنة الروائي (نقد أدبي) 2018
عناقيد نقدية (نقد أدبي) 2020
قِطاف وأوراق ( نقد أدبي) ( 2024)
تأملات وإضاءات في أعمال الملاح ( 2020)
درر ولطائف من القرآن الكريم ( 2020) دراسات قرآنية
همسات قرآنية ( 2024) دراسات قرآنية
من بطون التفاسير ج1 ( 2024) دراسات قرآنية
من بطون التفاسير ج2 ( 2024) دراسات قرآنية
الأعمال الإذاعية :
• (برنامج منوع ( دندنات كلمة من تقديم الأستاذ خلدون الكردي ،والأستاذة سمراء عبد المجيد .
• (من القرآن والسيرة( مسلسل تاريخي ديني، عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المولد .
الأعمال التلفزيونية: تم بثها من التلفزيون الأردني في التسعينات .
• (بساط الريح ( برنامج للأطفال في ثلاثين حلقة
• (الغاز وأمثال من التراث.( برنامج مسابقات في ثلاثين حلقة.
• أعمالي أيضا منشورة في مجلة صوت الجيل الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية.
• مجلة أفكار الأردنية.
• مجلة صوت الجيل الأردنية
• مجلة أقلام عربية
• مجلة مدارات الثقافية
• مجلة وسام ( مجلة أطفال)
• جريدة الرأي الأردنية .
• جريدة الدستور الأردنية .
• وغيرها من الصحف الأردنية والعربية . ( المغرب ، الجزائر ، الكويت )
• الجوائز / المركز الأول في القصة القصيرة في اتحاد الكتّاب والادباء الأردنيين للعام 2020م