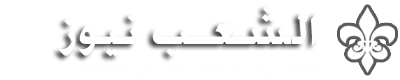المرأة والإدارة المحلية في الأردن: قراءة تحليلية في مؤشرات المشاركة والتحول السياسي د. زهور غرايبة
الشعب نيوز:-
تمثّل الإدارة المحلية في الأردن اليوم أحد المفاصل الأساسية في مشروع التحديث السياسي الذي أطلقته الإرادة الملكية عام 2021، بوصفها ركيزة لإعادة توزيع السلطة والمسؤولية، وإشراك المواطنين في صياغة القرار التنموي من القاعدة إلى القمة.
وتستند هذه الرؤية إلى قناعة راسخة عبّر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابات العرش المتعاقبة، مفادها أن تمكين المرأة والشباب شرط أساسي لتحقيق التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي وبناء دولة تشاركية قائمة على الكفاءة والمساءلة، والعدل والانصاف.
ويرى جلالته أن الإدارة المحلية هي الميدان العملي لترجمة الإصلاح إلى نتائج ملموسة، من خلال مجالس تمتلك الصلاحيات والموارد وتعبّر عن المجتمع بمختلف فئاته، بحيث يصبح التمكين السياسي للمرأة والشباب ركيزة في استقرار الدولة وتقدمها.
ويكتسب هذا المسار أهمية مضاعفة في ظل النقاش الدائر حول إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، يهدف إلى مواءمة البنية التشريعية مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي شددت على توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز تمثيل النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة.
ورغم أن الأردن راكم خلال العقدين الأخيرين خبرة مؤسسية في تطبيق اللامركزية، إلا أن تحليل المؤشرات المتعلقة بموقع المرأة في الإدارة المحلية والحياة الحزبية يكشف عن فجوة واضحة بين التقدم التشريعي والتمكين الفعلي، وهي فجوة لا ترتبط بنقص في الكفاءات النسائية، إنما بحدود البنية المؤسسية والاجتماعية التي ما زالت تقيد حضور المرأة في مواقع صنع القرار المحلي.
أولًا: المشاركة الحزبية النسائية – نمو كمي واستقرار هيكلي
تشير البيانات الرسمية إلى أن عضوية النساء في الأحزاب السياسية ارتفعت من 27.8% عام 2008 إلى 32% عام 2011، في سياق مرحلة سياسية تميّزت بانفتاح نسبي عقب الإصلاحات الدستورية، لكن هذه النسبة استقرت بعد عام 2012 عند حدود 30% تقريبًا حتى عام 2014، ما يعكس تباطؤًا في النمو نتيجة محدودية البنى التنظيمية وضعف تمويل الأحزاب وقدرتها على استقطاب العضوية النسائية.
ابتداءً من عام 2015، بدأت مؤشرات المشاركة النسائية تتقدم لتصل إلى 35.5%، وهي النسبة التي حافظت على ثباتها حتى عام 2021، ثم شهدت قفزة نوعية عام 2025 لتبلغ 42.97% من إجمالي المنتسبين للأحزاب وذلك بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
هذا الارتفاع لا يمكن تفسيره بمعزل عن الإصلاحات التشريعية التي طالت قانون الأحزاب لعام 2022، والتي ربطت التمويل بتمثيل النساء والشباب، كما لا يمكن فصله عن المناخ السياسي الذي أتاحه التحديث السياسي وخطابات الدولة الداعية إلى تمكين المرأة في البنية الحزبية، ورغم هذا التطور الإيجابي، يبقى التحدي في تحويل العضوية إلى نفوذ داخل الأحزاب، إذ ما تزال مواقع القيادة العليا في معظم الأحزاب ذات طابع ذكوري، ما يجعل المشاركة النسائية أقرب إلى “التمثيل العددي” منها إلى “التمثيل المؤثر”.
وبعبارة أخرى، أوجدت البيئة التشريعية عرضًا سياسيًا نسائيًا متناميًا، لكن الإدارة المحلية لم تتحول بعد إلى قناة تستوعب هذا العرض في مواقع القرار التنموي والسياسي.
ثانيًا: تمثيل المرأة في الإدارة المحلية – نمط مستقر حول حدود الكوتا
على المستوى المحلي، تُظهر البيانات اتساقًا لافتًا في نسب تمثيل المرأة عبر الدورات الانتخابية، إذ بلغت النسبة 27.4% في انتخابات 2008–2009، وتراجعت قليلًا إلى 24.8% في دورة 2010–2012، ثم ارتفعت إلى 30.6% عام 2013، لتستقر بين 27.8% و28.5% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024، هذا الثبات يشير إلى وجود “سقف بنيوي” لا يتأثر كثيرًا، ويعكس استمرار اعتماد تمثيل المرأة على نظام الكوتا أكثر من قدرته على المنافسة الحرة.
وتظهر نتائج انتخابات عام 2022 بصورة أكثر وضوحًا هذا القيد البنيوي؛ فقد بلغ عدد المترشحين والمترشحات 4794، شكّلت النساء 22% منهم، ولم تتقدم أي سيدة لمنصب رئيس بلدية، رغم غياب أي مانع قانوني.
أما النتائج النهائية، فقد أسفرت عن فوز 68 سيدة بالتنافس في المجالس البلدية و6 سيدات في مجالس المحافظات، إضافة إلى ما نسبته 25% من المقاعد المخصصة للنساء وفق نظام الكوتا، ورغم تحسن النسب مقارنة بانتخابات 2017 التي لم تتجاوز فيها مشاركة النساء في مجالس المحافظات 12%، فإن الارتفاع بقي محدودًا، ولم ينعكس في مواقع القيادة أو في رئاسة اللجان داخل المجالس.
التحليل المقارن لهذه الأرقام يقود إلى ثلاث ملاحظات أساسية:
أولًا، أن معدل ترشح النساء (22%) أقل بكثير من نسبة عضويتهن الحزبية (42.97%)، وهو ما يكشف عن فجوة انتقالية بين المجال الحزبي والمجال الانتخابي المحلي.
ثانيًا، أن غياب النساء عن رئاسة البلديات لا يمكن تفسيره قانونيًا، بل يرتبط بطبيعة التحالفات المحلية وشبكات النفوذ الاجتماعي والمالي.
وثالثًا، أن استمرار الاعتماد على الكوتا باعتبارها آلية تمثيل رئيسية أبقى التمثيل النسائي ضمن حدود رمزية، دون أن يحقق تحولًا في موازين القوة داخل المجالس.
ثالثًا: بين التمثيل والفعل – دلالات سياسية وتنموية
تؤشر هذه الأرقام إلى أن الأردن استطاع من خلال التشريعات أن يؤسس لمشاركة نسائية مستقرة، لكنها لم تترجم إلى فاعلية سياسية وتنموية، فالمرأة، رغم حضورها العددي في المجالس المحلية، لم تتحول إلى فاعل مؤسسي في رسم الخطط والموازنات المحلية أو قيادة اللجان ذات التأثير الحقيقي، وهذا يعني أن التحدي اليوم لم يعد في توفير “المقاعد”، بل في تحويل هذه المقاعد إلى أدوات قرار.
من منظور التحديث السياسي، تمكين المرأة في الإدارة المحلية هو اختبار مباشر لقدرة الدولة على تطبيق مبدأ اللامركزية كمفهوم للحكم الرشيد، وليس مجرد إطار إداري.
فوجود النساء في المجالس يعيد هيكلة عملية صنع القرار المحلي لتصبح أكثر شمولًا وتعبيرًا عن احتياجات المجتمعات، كما أنّ تعزيز مشاركة المرأة محليًا يُعدّ ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تربط بين النمو والتنمية البشرية والعدالة في توزيع الفرص.
رابعًا: متطلبات الإصلاح في القانون الجديد للإدارة المحلية
من المتوقع أن يشكّل القانون الجديد للإدارة المحلية اختبارًا عمليًا لمدى نضج التوجهات الإصلاحية، إذ يُنتظر أن يتضمن آليات واضحة لتمكين النساء والشباب في مواقع القرار المحلي.
ومن منظور السياسات العامة، تبرز خمس أولويات رئيسية:
1. تعزيز الصلاحيات الفعلية للمجالس المنتخبة وتمكينها من إدارة الشؤون التنموية والمالية ضمن أطر الحوكمة المحلية.
2. إعادة تصميم الكوتا النسائية بحيث تتحول من أداة تمثيل إلى أداة تمكين قيادي، من خلال تخصيص نسب لقيادة اللجان والمناصب التنفيذية.
3. ربط برامج بناء القدرات المحلية بمسار التحديث السياسي، بحيث تستهدف تطوير مهارات النساء المنتخبات في مجالات الإدارة والميزانية والتخطيط التشاركي.
4. تفعيل الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في رصد أداء المجالس وتعزيز الشفافية والمساءلة.
5. إدماج النساء والشباب في عملية صنع القرار بوصفها ركيزة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تكشف القراءة المترابطة للأرقام أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في ترسيخ المشاركة النسائية على مستوى التشريع والوعي، لكنه ما يزال في طور التحول نحو تمكين فعلي على مستوى القيادة والإدارة المحلية، وتبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر تكاملًا بين التشريع، والسياسات الحزبية، وبناء القدرات، حتى تتحول المشاركة من حالة عددية إلى ممارسة مؤسسية.
فالتحول الديمقراطي لا يُقاس بارتفاع نسب التمثيل فحسب، بل يشمل مدى قدرة النساء والشباب على التأثير في القرار المحلي والوطني معًا — وهو الهدف الجوهري الذي تسعى إليه الإرادة السياسية العليا في مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.