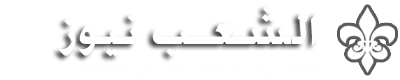صوت الماء وصوت العقل: تأملات في رحلة الإنسان نحو اليقين..سعيد ذياب سليم
الشعب نيوز:-
هل يكفّ الإنسان يومًا عن البحث؟ وعن ماذا يبحث أصلًا؟
أعن ذاته، أم عن سعادته، أم أنّ الحياة في جوهرها مغامرة لا تنتهي ما دام القلب قادرًا على النبض والقدم على السير؟
وما الذي يوجّه أهواءنا في هذا الطريق؟ أهو الحب، أم الشهوة، أم ذاك الظمأ الخفيّ للمعرفة؟ أم هي محاولات صغيرة لتعويض خيباتٍ مرّت بنا وتركت في أرواحنا فجواتٍ لا تلتئم؟
منذ أن تعلّقنا في طفولتنا بصدور آبائنا وأمهاتنا بدأ بحثنا الأول؛ امتدّت أيدينا الصغيرة نحو العالم نتعرّف، نلمس، نتذوّق، ونتلقّى صلواتنا الأولى كما نتلقّى الحكايات. ثم جاءت تلك اللحظة التي يختار فيها كلٌّ منا طريقه الخاص، لحظة الثورة الهادئة، فنجرّب ونسافر ونتغيّر، ويكبر فينا ذلك الجوع القديم… ولا نشبع.
ومن قرية إلى مدينة، ومن مدينة إلى أخرى، نلاحق ذلك النداء الغامض: نبحث عن الحقيقة، حتى لو كانت بلا اسم. وهذا النداء ذاته شكّل جوهر رواية سدهارتا (1922) لهرمان هِسّه، التي قدّمت رحلة شاب براهمي نبيل يبحث عن ذاته وسط عالم يموج بالتعاليم والرغبات.
كان سدهارتا من أسرة متديّنة تتبع التعاليم البراهمية، لكنه أدرك مبكرًا أن المعرفة لا تُنال بالتقليد أو تقديم القرابين، فترك بيته والتحق بطائفة السامانا الزاهدة. هناك مارس الصوم والتجرّد والتأمل لسنوات. ثم التقى غوتاما (بوذا)، فأعجب بتعليمه لكنه رفض اتباعه، فالحكمة بالنسبة إليه لا تُستعار، بل تُكتسب عبر التجربة الشخصية.
واصل رحلته إلى المدينة، حيث التقى كمالا، المرأة التي أصبحت معلمته في فن الحب، واشترطت عليه أن يتعلّم التجارة ويعرف قيمة المال. ومن زاهد بسيط تحوّل إلى رجل ثري محاط بالترف والشهوة، إلى أن غمرته قسوة الاشمئزاز من نفسه، وشعر أن روحه تتسرّب منه كما يتسرّب الماء من كفٍّ مبسوطة.
عاد إلى النهر، وهناك وجد الملاح فاسوديفا الذي علّمه الإصغاء إلى حكمة الماء الجاري. وفي إحدى زياراتها لبوذا كانت كمالا في طريقها إلى الغابة مع ابن سدهارتا، فلدغتها أفعى وماتت بين يديه، تاركة له روحه الجديدة: ابنه. لكن الابن تمرّد وهرب إلى المدينة، كما كان أبوه قد هرب من أبيه يومًا ما. وحين لحقه سدهارتا سمع خرير الماء يذكّره بأن الحياة دائرة، وأن الفرح والحزن جزء من الرحلة.
وتنتهي الرواية بلحظة صفاء يدرك فيها سدهارتا أن الحكمة ليست في الهرب ولا في التشبث، بل في الإصغاء إلى الحياة كما هي، والقبول بدورانها.
وتقدّم الرواية رحلة روحية متدرجة عبر مراحل الحياة الهندية:
البراهمية، الزهد، الحب، المال، الأبوة، التنوير.
غير أنّ هِسّه لا يلتزم بدقة تاريخية أو دينية صارمة؛ فهو يوظّف مصطلحات مشتركة بين الهندوسية والبوذية مثل “أوم” و”آتما” و”النيرفانا” و”الكارما”، ويخلط أحيانًا بين الديانتين في إطار فلسفة موحّدة أقرب إلى “وحدة الوجود”.
وهنا يبرز النقد الأساسي للرواية؛ فهي تحاكي رحلة غوتاما بوذا لكنها تبسّطها وتعيد صياغتها بروح غربية تميل إلى الروحانية الهادئة. كما أنها تصنع شرقًا مثاليًا، نقيًا وساكنًا وحكيمًا، بعيون غربية تبحث عن السكينة أكثر مما تبحث عن الحقيقة التاريخية. وتقدّم النهر بوصفه “لحقيقة الكبرى” التي تحتوي التناقضات كلها: الزهد والشهوة، العمل والفراغ، الفرح والحزن، وهي رؤية جميلة ومؤثرة لكنها أقرب إلى التأملات الفلسفية منها إلى تصوير واقعي للديانات الهندية.
ومع ذلك، تبقى سدهارتا رواية عن الإنسان قبل أن تكون عن الشرق؛ عن ذلك العطش القديم الذي يسكننا جميعًا… بحثنا الأبدي عمّا لا اسم له، وعن الحقيقة التي لا تُفهم إلا حين نملك الشجاعة للإصغاء.
ويُعدّ كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان (1970) للدكتور مصطفى محمود واحدًا من أبرز السير الفكرية في المكتبة العربية؛ فهو ليس مجرد عرض لمقالات دينية، بل شهادة فكرية طويلة امتدت لقرابة ثلاثين عامًا من البحث والقلق والتأمل، بدأت منذ شبابه حين فتح عينيه على صوت العلم ومنجزاته.
نشأ مصطفى محمود في عالم يحتفي بالعقل وأدواته، فبدأ رحلته مراهقا بين مكتبة البلدية ومختبره الصغير، متأثرًا بالمنهج العلمي الذي لا يقبل الغيبيات. وخلال دراسته للطب ازدادت قناعته بالمحسوس والمادي، فمال إلى تفسيرات تقوم على وحدة الوجود وفكرة التناسخ، وكتب في هذا الاتجاه أعمالًا مثل الخروج من التابوت. ولم يكن إنكاره للإله إنكارًا صريحًا، بل تصورًا غامضًا يرى فيه قوة داخلية تنبض بها الحياة والكون.
لكن هذا المسار لم يدم طويلًا؛ فالعلم ذاته كان، كما يروي في الكتاب، سببًا في تخليه تدريجيًا عن تلك الرؤى. إذ وجد أن التشابه بين الكائنات لا يدل على وحدة الوجود بقدر ما يكشف عن وحدة العناصر التي تكوّن الحياة، وعن الدقة المذهلة التي تعمل بها الخلية، بما يتجاوز تفسير الصدفة. ومن هنا بدأ انتقاله من الشك الفلسفي إلى بناء حجج عقلية أكثر صلابة.
محاور البحث في الكتاب
1. البحث عن الحقيقة الكونية: الله
يناقش الأسئلة الوجودية الكبرى حول الخالق والوجود والعدم، ويعرض حجج الشك التي طرحها مثل سؤال “خالق الخالق”، ثم يفككها بمنطق السبب الأول و”واجب الوجود”، ليرى أن الإيمان هو ما تتسق معه الفطرة والعقل معًا.
2. البحث في حقيقة الإنسان: الجسد والروح
يبيّن دقة الخلق وتفرّد الإنسان ببصمته الوراثية، ويرفض اختزال الإنسان في دوافع بيولوجية فقط، مؤكدًا وجود “الصحو الداخلي” أو الروح التي لا تخضع للقوانين المادية وحدها.
3. البحث في معنى العدل والغاية
يتناول مسألة الظلم والألم، ويشرح كيف يتسق وجودهما مع العدالة الإلهية، ويبيّن أن إدراكنا المحدود يجعلنا عاجزين عن رؤية الصورة الكاملة، وأن توق الإنسان الفطري للعدل دليل على وجود عدل مطلق في عالم آخر.
خلاصة الرحلة
يُقِرّ مصطفى محمود بأن الشك كان نقطة البداية، والإيمان محطة الوصول. والكتاب بذلك ليس دعوة عقائدية، بل شهادة إنسانٍ عاش رحلة فكرية حقيقية، استخدم فيها العلم والمنطق والتأمل، وانتهى إلى قناعة بأن الإيمان ليس نقيض العقل، بل ثمرة من ثماره.
وقد واجه خلال هذه الرحلة جولات من الجدل؛ فصودرت كتبه الأولى حين مال إلى المادية ووحدة الوجود، ثم اتّهم لاحقًا بالتقلب الفكري بعد تحوّله إلى الإيمان العميق، ودخل في سجالات مع رجال الدين بسبب تفسيراته العقلية، ومع مثقفين بسبب استقلاله عن التيارات السائدة. ومع ذلك بقي صوته مؤثرًا بفضل صدقه وإخلاصه للبحث.
وبين رحلة سدهارتا الخيالية ذات النكهة الرومانسية، ورحلة مصطفى محمود الفكرية الواقعية، يبقى لكلٍّ منّا طريقه الخاص في البحث عن حقيقةٍ ما؛ حقيقةٍ قد تولد في القلب همسًا، أو في العقل سؤالًا، أو في الحياة تجربةً تغيّر كل شيء.
ومنذ أن خرج جلجامش باحثًا عن الخلود ليقهر الموت، وخرج سانتياغو يبحث عن كنزه كما صوّر باولو كويلو في الخيميائي، أدرك السائرون في دروب المعرفة أنّ القيمة ليست في الوصول، بل في الرحلة ذاتها وما تكشفه لنا من معنى.
لذلك، لا تتردّد في بدء رحلتك الخاصة؛ فكما يقول كويلو:
“إذا رغبتَ في شيء، فإنّ الكون كلّه يتآمر معك لتحقيق رغبتك.”