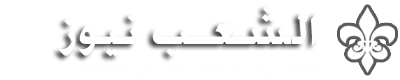تقنية التشويق وأدواتها في “أنا يوسف يا أبي” للروائي د. باسم الزعبي بقلم: أسيد الحوتري
الشعب نيوز:-
إنّ تنوع تقنيات السرد في العمل الروائي يُعدّ شرطا بنيويّا وجماليّا لنجاحه، إذ إنّ النص الروائي الفقير تقنيّا غالبا ما يتّسم بالسطحية والجمود، مهما كان موضوعه غنيّا أو أفكاره عميقة. فالتقنية ليست مجرّد عنصر شكلي يُضاف إلى البنية الروائية، بل هي إطار عام فاعل ينظّم السرد ويضبط إيقاعه ويتيح للكاتب إعادة تشكيل الزمن والشخصيات والأحداث في إطار فني يمنح العمل حيويته وقدرته على إثارة القارئ. ومن هنا، فإنّ الاقتصار على سرد خطي مباشر لا يوظّف الإمكانات التقنية المتاحة كثيرا ما يفضي إلى رواية فقيرة جماليًّا وغير قادرة على ترسيخ حضورها في المشهد الأدبي.
وتتجلّى أهمية تقنيات السرد في تعدّد طرائقها ووظائفها، فـ “الاسترجاع” يمكّن النص من العودة إلى الماضي بوصفه أداة إضاءة للحاضر وتعميقا للأبعاد النفسية والتاريخية للشخصيات، بينما يقوم “الاستباق” بكسر خطية الزمن عبر الإشارة إلى ما لم يقع بعد، الأمر الذي يمنح السرد توترا زمنيا ويضاعف من أفق الترقب. كما أنّ “تعدّد الأصوات” يتيح للرواية غنى دلاليا عبر إدخال وجهات نظر متباينة حول الحدث الواحد، في حين يُمثّل “تيار الوعي” وسيلة فنية لاختراق العالم الداخلي للشخصيات وتقديم خطابها النفسي بما يعكس تعقيدات الذات الإنسانية.
ورغم هذا التنوّع تبقى تقنية “التشويق” في مقدّمة التقنيات السردية من حيث الأهمية، نظرا إلى وظيفتها الجوهرية في ضمان تواصل القارئ مع النص حتى ختامه. فالتشويق ليس مجرد عنصر تزييني أو أداة ثانوية، بل هي محرّك العمل الروائي، إذ من دونه يفقد النص عنصر الجذب وتضعف قابليته على شدّ المتلقي، مهما بلغ من ثراء موضوعي أو فكري. إنّ التشويق هو ما يجعل القارئ في حالة ترقب وانتظار دائم، ويؤسّس للعلاقة الجدلية القائمة على التجاذب والشد بين النص والمتلقي.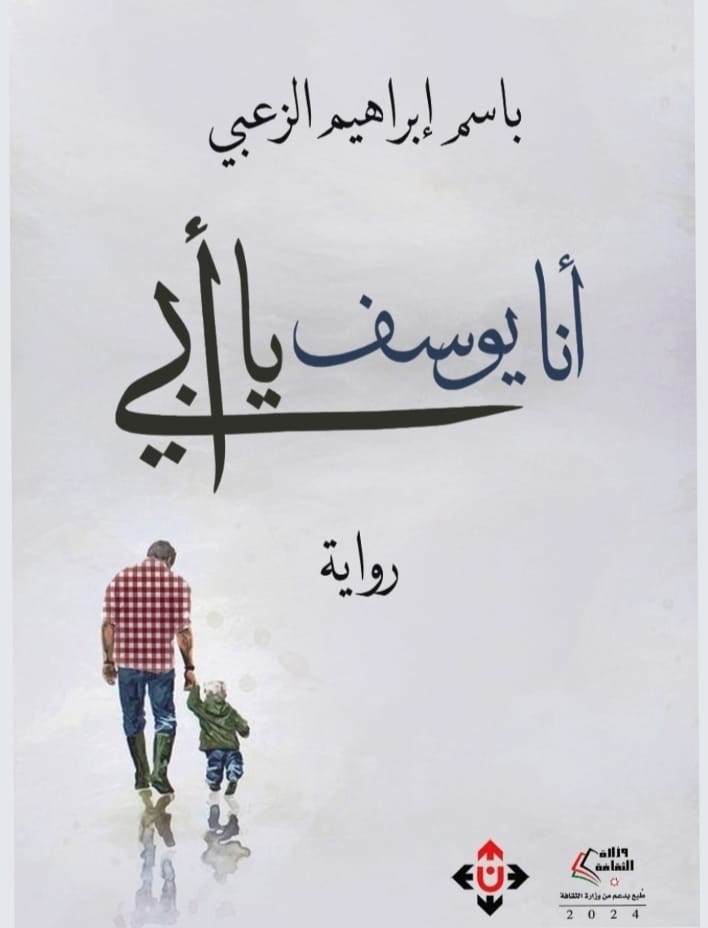
ولتحقيق هذه التقنية يعتمد الروائي على جملة من الأدوات الفنية، أبرزها “الإخفاء المتعمّد للمعلومات” وتأجيل كشف بعض الحقائق إلى اللحظة المناسبة، و”القطع المفاجئ للسرد” عند منعطف حاسم بما يترك القارئ في أفق الترقب، إضافة إلى “تسريع الإيقاع السردي” من خلال جمل قصيرة متلاحقة تعكس توتر الأحداث. كما أنّ “المفارقة الدرامية” تمثّل أداة أساسية حين يطّلع القارئ على ما تجهله الشخصيات، بما يضاعف من التوتر النفسي ويعزّز الرغبة في المتابعة ليتعرف القارئ على ردة فعل الشخصيات عندما تعلم ما قد سبقهم به علما. ولا يقلّ عن ذلك أهمية توظيف “الغموض والأسئلة المفتوحة” التي تُبقي وعي المتلقي في حالة من الترقب المستمر والبحث عن إجابة داخل النص.
وعليه، يمكن القول إنّ نجاح الرواية الحديثة رهين بقدرتها على الموازنة بين التنوّع التقني الذي يثري بنيتها الجمالية، والتشويق الذي يحافظ على جاذبيتها القرائية، بحيث يتكامل البعد الفني مع البعد الحكائي في صياغة عمل روائي متماسك ومؤثّر.
يشكّل عنصر التشويق في الرواية الحديثة بُنية جمالية متعدّدة المستويات، تُبنى من خلال تضافر عدد من الأدوات الفنية التي تهدف إلى شدّ القارئ وإبقائه في حالة من الانشداد المستمر إلى النص. ومن أبرز هذه الأدوات ما يتجلى في رواية “أنا يوسف يا أبي”، حيث يوظَّف الغموض والأسئلة المفتوحة، والتشويق النفسي، والإيهام بالواقع، والمفاجأة السردية، والتوتر الدرامي، وتعدد الحبكات، والمفارقة السردية بوصفها أدوات فنية وعناصر بنائية تتجاوز الوظيفة التزيينية إلى كونها آليات أساسية في هندسة الرواية.
يقدم “الغموض” بوصفه أداة فنية محورية، إذ يُبنى على تقديم معلومات ناقصة حول دوافع الشخصيات أو أحداث ماضيها، مما يفتح أفقا من التساؤلات لدى القارئ. يتجلّى ذلك في شخصية (غالينا) على نحو خاص، حيث يحيط الغموض بعلاقتها المعقدة مع عون ومحمد، وبماضيها الشخصي الذي يُلمّح إليه عبر إشارات متعددة، من بينها تغيير اسمها إلى “هيلين”، وطبيعة علاقتها مع (فلاديمير) والتي يتضح فيما بعد أنه عشيقها التي تخون زوجها معه.
ومنذ البداية يوظّف السرد أداة بناء “الأسئلة المفتوحة”. ففي حادثة غياب عون عن مرافقة أسرته إلى المطار يتساءل السارد: “ترى هل حدث معه شيء أنساه موعد الطائرة.” (ص 18) هذا السؤال المفتوح يخلق لدى القارئ انشدادًا لمعرفة مصير عون: هل سيلحق بالطائرة أم لا؟ وما أسباب غيابه؟ إن تعليق الإجابة هو ما يمنح النص بعدًا تشويقيًا مبكرًا يترسّخ مع تقدّم السرد.
ويتعمّق هذا التشويق من خلال ما يمكن تسميته بأداة “التشويق النفسي” (Psychological Suspense) ، حيث يظل القارئ متابعا لصراع عون الداخلي بين خيار المواجهة مع الفساد وخيار الهروب منه: “هل يستطيع الهرب؟ لماذا لم يواجه الفساد؟ إنه يهرب…” (68) إنّ إبراز هذا الصراع النفسي يجعل القارئ متسائلا عن نتائج اختيارات البطل، ومنخرطا وجدانيا في متابعة مصيره، بما يعكس براعة الكاتب في توظيف التوتر الداخلي كآلية أو أداة تشويقية.
وتتعزز آليات التشويق عبر أداة “الإيهام بالواقع” (Illusion of Reality)، إذ تُدمج اليوميات السياسية والاجتماعية في النسيج الروائي، لتُضفي على النص طابعًا واقعيًا. نقرأ: “عاصفة بكل ما مرّ به العالم المحيط… حرب العراق، الانتفاضة الفلسطينية، غزو الكويت. …” (66) إن هذه الاستدعاءات للأحداث التاريخية تُقرّب النص من الواقع، وتمنح القارئ شعورًا بأن ما يقرؤه ليس متخيَّلًا خالصا، بل هو امتداد لتجربة واقعية، مما يعزّز من مصداقية السرد ويضاعف من فاعلية التشويق.
أما أداة / آلية “المفاجأة السردية” (Narrative Surprise)، فتظهر في مشهد اكتشاف محمد لمكالمة والدته (غالينا) باللغة الروسية (22). هذا الكشف المفاجئ يُقدّم وجها جديدا للشخصية، إذ تتحوّل غالينا من امرأة غامضة وقلقة إلى شخصية تحمل استياء وربما خيانة محتملة. فالمكالمة تكشف شكواها من زوجها ومن البلد، الأمر الذي يبدّل موقعها في وعي ابنها محمد، ويؤثّر في سلوكه اللاحق مثل التدخين والعصبية. هذه المفاجأة تفتح أسئلة جديدة: هل تخطّط غالينا لأمر سري؟ هل ستؤثر هذه الشكوى على تماسك العائلة؟ وهكذا يتحوّل الكشف السردي إلى أداة لتوليد التوتر العاطفي واستدامة الانشداد القرائي.
وفي السياق ذاته، يبرز “التوتر الدرامي” (Dramatic Tension) بوصفه أحد أهم أدوات التشويق. والتوتر الدرامي هو الصراع الداخلي أو الخارجي الذي تواجهه الشخصيات، والذي يولّد شعورا بالقلق والترقّب لدى القارئ. ويُبنى من خلال تعليق الحلول، أو تصعيد الصراعات، أو إثارة الأسئلة حول المصير. في رواية “أنا يوسف يا أبي” يتجلّى هذا التوتر في أكثر من موضع: قلق غالينا في المطار بسبب تأخّر عون عن موعد الطائرة (15-17)، وصراع محمد عند وصوله إلى تركيا حيث يشكّ في قراره بالانخراط في الجهاد والعودة إلى روسيا (136)، وازدياد قلقه مع حمزة عندما يطلب جوازه فيتحوّل من صديق موثوق إلى غريب مشكوك فيه (144). في هذه الأمثلة يظهر التوتر الدرامي في أبعاده النفسية والاجتماعية، ليضاعف من هشاشة الشخصيات وقلق القارئ على مصيرها.
ويكتمل البناء التشويقي من خلال أداة الفنية أو الآلية السردية تعدد الحبكات، إذ لا يكتفي النص بحبكة رئيسية واحدة بل يقدّم شبكة من الحبكات الفرعية التي تتقاطع فيما بينها. فالحبكة المركزية تتعلق برحلة عون والسفر، بينما تتوزع الحبكات الفرعية على علاقة (غالينا) بعون وولدها محمد، وعلى علاقة محمد بوالديه، وعلى ارتباط عون بعائشة وصالح، إضافة إلى الحبكة الرمزية المتصلة بيوسف. هذا التعدد في الخطوط السردية لا يثري البنية فحسب، بل يعمّق تقنية التشويق، لأن كل حبكة فرعية تثير فضول القارئ وتفتح أمامه تساؤلات جديدة، في ظل توازن دقيق يحافظ على انسجام العمل.
كما تُعد “المفارقة الدرامية” من التقنيات السردية التي تمنح الرواية بعدا تشويقيا إضافيا، لأنها تقوم على المفارقة بين ما يعرفه القارئ وما تجهله الشخصيات داخل النص. هذا التفاوت في المعرفة يضاعف من انفعال القارئ، إذ يبقى متأهّبا لرؤية لحظة انكشاف الحقيقة أمام الشخصيات، منتظرا ردود أفعالها المحتملة. وفي رواية موضوع الحديث يوظّف الكاتب هذه التقنية بمهارة في أكثر من موضع، الأمر الذي يعمّق التوتر ويغني التجربة القرائية.
يتجلّى المثال الأبرز للمفارقة الدرامية في المكالمة الهاتفية التي يسمعها محمد بين والدته (غالينا) وشخص آخر، حيث يتأكّد من خيانتها لوالده. هنا ينكشف للقارئ ولشخصية محمد معا هذا السر، بينما تبقى بقية الشخصيات الأخرى غافلة عنه. إنّ معرفة القارئ بهذه الحقيقة قبل بقية الشخصيات تولّد لديه شعورا بالترقب والقلق من لحظة المواجهة الممكنة، كما تفسّر التحوّل الكبير الذي طرأ على سلوك محمد لاحقا، بما في ذلك العصبية والانغلاق والتوجّس. هذه المفارقة تجعل القارئ أكثر التصاقا بمسار الشخصية، لأنه يدرك خفاياها بينما الآخرون داخل النص بعيدون كل البعد عن إدراكها.
ويبرز مثال آخر على المفارقة الدرامية في تواصل محمد، الذي يحمل اسم يوسف عون، مع أخته ريمة عبر الفيسبوك (221). فالقارئ يعرف منذ البداية أن يوسف هو في الأصل محمد، في حين تبقى ريمة جاهلة بهذه الحقيقة حتى النهاية. إنّ متابعة هذا التفاعل بين الأخوين، في ظل وعي القارئ بالهوية الحقيقية ليوسف، يخلق توترا عاطفيا متزايدا، لأن القارئ يتوقّع اللحظة التي ستكتشف فيها ريما الحقيقة، متسائلا عن وقعها عليها وعن انعكاسها على بقية الشخصيات. هذه المفارقة لا تضيف فقط عنصر التشويق، بل تسهم في تعميق الجانب النفسي والعاطفي للرواية، لأنها تكشف عن مأساة الانقسام الأسري في ظل الأسرار والخيانات.
وعليه، يمكن القول إنّ المفارقة الدرامية في “أنا يوسف يا أبي” لا تقتصر على كونها آلية سردية، بل تتحوّل إلى أداة لزيادة التوتر، وتعزيز التشويق، وتكثيف البعد المأساوي، لأنها تمنح القارئ موقعا معرفيا متقدّما على الشخصيات، وتجعل علاقته بالنص قائمة على الانتظار والترقب والتأويل المستمر
في ضوء ما سبق، يتضح أنّ نجاح الرواية لا يُقاس بمجرد ترتيب الأحداث أو غنى الموضوعات، بل بقدرتها على توظيف تقنيات سردية متعددة تُنظّم السرد، وتولّد التوتر، وتدفع القارئ إلى الانخراط العاطفي والفكري. فالغموض، وبناء الأسئلة المفتوحة، والتشويق النفسي، والإيهام بالواقع، والمفاجأة السردية، والتوتر الدرامي، وتعدد الحبكات، إضافة إلى المفارقة الدرامية، تشكّل شبكة متكاملة من الأدوات الفنية التشويقية التي تمنح النص الحيوية والعمق، وتخلق تجربة قراءة غنية وممتدة الأثر. إن هذه التقنيات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتداخل وتتكامل لتوليد ما يمكن تسميته بـجماليات التلقي، حيث يصبح القارئ شريكًا فعّالًا في بناء المعنى، متفاعلاً مع كل مستوى من مستويات السرد، متأثّرًا بالصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ومتطلّعًا إلى لحظة الانكشاف والمفاجأة. وبذلك، تتحول الرواية إلى عمل فني متكامل، يحقق التوازن بين البعد الفني والبعد الحكائي، ويؤكد أن التنوّع التقني ليس خيارا جماليا فحسب، بل ضرورة أساسية لإنتاج نص روائي مشوّق قادر على شدّ القارئ وإشراكه في تجربة معرفية وعاطفية متكاملة.