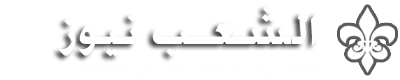الادارة التي لا تقود…مأزق المؤسسات أمام الكفاءات البرفسور عبد الله سرور الزعبي
الشعب نيوز:-
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
في المسار الطويل للأمم، تظهر لحظات فاصلة تدرك فيها الشعوب أن مستقبلها لا يُصنع بالصدفة، ولا بالشعارات، بل بالكفاءات، والقيادات القادرة على اتخاذ القرار. وفي اقليم مضطرب مثل الشرق الأوسط، يجد الأردن نفسه اليوم أمام لحظة من هذا النوع، لحظة يصبح فيها الاستثمار في العقل الوطني ضرورة وجودية لا خيارًا تجميليًا.
لكنّ المشهد الأردني يكشف مفارقة مؤلمة، كفاءات تمتلك العلم والخبرة والرؤية والجرأة تُستبعد، فيما تُفتح الأبواب لبعض من لا يملكون إلا الضجيج والعلاقات والقدرة على الانحناء. هذه ليست أزمة إدارية او ازمة وظائف، بل أزمة فلسفة إدارة وفكر، تمامًا كما حذّر ماكس فيبر حين قال “حين تستبدل البيروقراطية الكفؤة، بالولاءات المختلفة، تتحول إلى ماكينة تعطيل”.
على مدار عقدين، أكد الملك على ان الكفاءة والجرأة في اتخاذ القرار تتقدم على الولاءات الضيقة، وأن سيادة القانون، والمساءلة، والشفافية، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، هي شروط النهضة. وقد وضع عبر الأوراق النقاشية والرسائل الملكية خارطة طريق مكتملة للوصول الى الدولة الحديثة، من خلال إصلاح التعليم كجوهر النهضة، وتطوير الإدارة، وتعزيز الديمقراطية، وبناء القدرات البشرية.
بين الرؤية الملكية، التي هي في القمة، والطريق المؤدي إليها، تقف مؤسسات تُقاوم التغيير أكثر مما تُقاوم الفشل. تُهدر فيها الطاقات، وتُصنع فيها الإحباطات، وتُقصى الكفاءات، ويتصدر من لا يستحق، ويُدوَّر بعض الفاشلون دون محاسبة، وبلا سؤال، كيف استلمت المؤسسة؟ وكيف تركتها؟ وماذا حققت؟ وما أثر قراراتك على الناس والمال العام؟
إن غياب هذه الأسئلة هو الذي جعل مشروع الإصلاح يتقدم خطوة ويتراجع خطوات.
مع اقصاء الكفاءة والمساءلة، يستمر نقل الفشل من موقع إلى آخر، ويستمر آخرون في طرح مشاريع يعرفون، مسبقًا، أنها لن تحقق نتائج، لكن إيقافها يعني فقدان الموقع والاعتراف بالخطأ، وهو اعتراف يراه البعض أثقل من الجريمة نفسها.
وهو ما يلخصه تشرشل “الأمة التي تُقصي أفضل رجالها تصنع بأيديها طريق أزماتها”. ويؤكد عليه لي كوان يو بقوله “أضعف الدول هي التي تمنح المواقع لمن يجيد الوصول لا لمن يجيد العمل”.
وهذا تعبير واضح عن الكثير من المواقع في الإدارة الاردنية، فالكفاءات ليست صامتة لأنها بلا رأي، بل لأن التجربة علمتها أن الخبرة لا تكفي لفتح الباب، بينما تُفتح الأبواب لمن يرفع صوته، ويجيد التقرب، وينمق الرواية. فالمشكلة في منظومة إدارية تفضّل المطيع على المبدع، والمتشابه على المختلف، وتنظر إلى المنصب كغنيمة لا كمسؤولية. وقد لخّص بيتر دركر ذلك بدقّة “أسوأ ما تفعله المؤسسات هو أن تضع الأشخاص الخطأ في الأماكن التي تحتاج الأشخاص الصح”.
إن اقصاء وإحباط الكفاءات، أصبح أزمة إدارة وطنية، تنتج مؤسسات هشة، وقرارات مرتبكة، ومبادرات لا تعيش أكثر من عمر أصحابها في الموقع الاداري. ومع كل موجة إحباط جديدة نخسر طبيبًا كان يمكن أن ينقذ قطاعًا، وأكاديميًا قادرًا على إصلاح جامعة، ومهندسًا قادرًا على تحويل رؤية إلى مشروع، واقتصاديًا قادرًا على إعادة صياغة الخيارات الوطنية. هذه الحالة عبر عنها غاسيت قائلاً “في اللحظة التي يتقدم فيها غير المؤهل، ينهزم المجتمع قبل أن تبدأ المعركة”. نعم، المعركة تُحسم عند لحظة اختيار الشخص المناسب، لا عند لحظة اتخاذ القرار.
التاريخ يقدم درسًا لا يخطئ، فإن أفضل ما يمكن أن تفعله الأردن، بمواردها الشحيحة، استخدام كفاءاتها، فهي رأسمال والسلاح الحقيقي في عالم لا يعترف بالنيات بل بالنتائج.
إنّ التوجيهات والأوراق الملكية، لأكثر من عقدين، عبارة عن خارطة طريق، لو تحولت إلى التزام من قبل الإدارات، تبدأ من اصلاح التعليم وتنتهي بالاقتصاد، مرورًا بإصلاح الإدارة العامة وتحرير الكفاءات من قيود الإقصاء.
والسؤال الجوهري اليوم هو من يحمي من يعرقل، ومن يؤجل، ومن يخفي الأخطاء، ومن يبرر الفشل، وأولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ الرؤى الملكية؟
التعليم، الأكثر وضوحًا لهذه الحالة، وهو القطاع الذي دعا الملك إلى إصلاحه مراراً. جُرّب فيه كل شيء، حتى أصبح مسرحًا للتجارب المتعاقبة، وخطط واستراتيجيات، تُعلن ولا تُنفذ، جرّبنا المركزية، واللامركزية، ولم يبقَ نموذج تعليمي إلا وتم تجربته، ومناهج تتغير، وسياسات متناقضة، ومشروع تطوير يتبعه تصويب، ثم هيكلة، يتبعه تعديل. لكن النتائج كانت تراجعًا يتلوه تراجع، حتى تجاوز فيه الفقر التعليمي 60℅ والفاقد 50℅.
في كل مرة، يُقال إن التجربة لم تنجح وإن المرحلة الجديدة ستكون مختلفة، ثم يتبين أنها ليست إلا نسخة أخرى من التخبط، يهُزم فيها العقل، حتى بات التعليم يمشي في دوائر مغلقة.
التعليم المهني والتقني، أصبح تريندًا، ويُرفع اليوم كشعار، ويتحدث به الجميع، والبعض لا يعرفون جوهره، ولا شروطه، ولا فلسفته، ولا بنيته، ولا ارتباطه بسوق العمل المستقبلي.
الأخطر، ان بعض القيادات الاكاديمية ممن تصدروا المشهد، خلال السنوات، لم يكونوا أصحاب رؤية، بل أصحاب علاقات. والسؤال لماذا لم تتحقق النتائج المطلوبة على ايديهم؟ رغم تكرار معظمهم في المواقع القيادية. وكأننا نحول الفشل الوظيفي إلى خبرة تُكافأ بتعيينات جديدة، لتتكرر التكلفة، ويتكرر الإنكار! حتى أصبح، وكأنه اقتصاد الظل الإداري القائم على تدوير الوجوه لا تدوير الأفكار.
والسؤال، هل تمّت المساءلة، لأي مسؤول في قطاع التعليم عن فترة وجوده في منصبه، وهل سُئل، كيف استلمت المؤسسة؟، وكيف تركتها؟ وما القرارات التي اتخذتها؟ وما أثرها المالي؟ وما أثرها التنموي؟ وهل حققت الهدف أم أضعت الوقت والمال؟ واحياناً نسمع روايات مختلفة بين مسؤول ترك موقعه واخر استلم مكانه، فهل أجرينا مواجهات علنية بينهما لكشف الحقيقة للناس؟ ولكيلا تتكرر مثل هذه المواقف يساء فيها للمؤسسات، وتغتال فيها شخصيات لمواقفها الحازمة بتطبيق سيادة القانون، وعدم مهادنتها على مصلحة المؤسسة.
إذا لم تُسأل هذه الأسئلة، فلا معنى للمحاسبة، ولا معنى للشفافية، ولا معنى لتجديد الثقة أو سحبها.
من المؤسف ان بعض من وصلوا إلى قمة الهرم الأكاديمي، لا يجب أصلًا أن يكونوا في الجسم الأكاديمي. فغياب الهواء النظيف يسمّم الأجواء ويجعل الفشل مستدامًا والإحباط منهجيًا. وهذه الحالة نجدها في تعبير وايتهيد “التعليم الذي يقوده الجهل، ينتج جهلاً مؤسسيًا”. والسؤال، واليوم هل شاهدتم خلال اخر سنوات، رؤساء الجامعات، الذين من المفترض انهم قادة المجتمعات الفكرية يتحدثون الى المجتمع ويحاورون الشباب عن القضايا الوطنية الساخنة؟
فالإصلاح لا ينجح حين يديره أشخاص لا يعرفون جوهر التعليم، فالتعليم لا يُصلح بالنوايا، ولا ينهض بمن يجهلون جوهره، ولا تدار مؤسساته بحسن الظن.
لقد آن الأوان، أن تدرك المؤسسات، أن الكفاءة ليست خصمًا، بل حليفها الأول، فالعقول التي تُقصى، لا تموت، لكنها تهاجر، أو تتألم بصمت، أو تكتفي بالمشاهدة، وتصبح من فئة اللامبالاة، رغم أنها الأكثر صدقًا والأشد إخلاصًا. وهي نسخة أردنية لما وصفه دوستويفسكي، حين يصبح الإنسان الصادق مُهانًا مرتين، مرة لأنه صادق، ومرة لأنه يرى الكاذب يُكافأ، وعندها تخسر الأوطان أفضل أبنائها.
اليوم، نرى آثار ذلك، كفاءات تُهاجر لأنها دُعيت إلى الهجرة صراحةً، وكأن الأردن لا يحتاجها، أو أن المسؤولين أدّوا واجبهم على أكمل وجه، ولم يعد أمامهم سوى القول لأصحاب العقول “ابحثوا عن وطن تجدوا فيه انفسكم”. هذا إعلان عن فشل إداري، وغياب للرؤية، وتنصل من المسؤولية. وكأنه غاب عن أصحاب دعوات هجرة الكفاءات قول دوستويفسكي “حين لا يجد الصادق مكانًا في وطنه، يصبح الوطن نفسه بحاجة إلى إصلاح”، وان الدولة التي تطلب من كفاءتها الرحيل، تمارس انسحابًا من مستقبلها، ويجب على الجميع ان نتذكر دعوة الملك الى الاستثمار بالكفاءات لا تصديرها.
وفي قلب هذا المشهد، تتشكل قاعدة غير مكتوبة “لا تسبق من فوقك، ولا تغيّر ما تعارف عليه غيرك، ولا تكن جريئًا، او كفؤًا إلى الحد الذي يحرج المؤسسات الاخرى، وهكذا تبدأ صناعة الإحباط.
اليوم، والأردن يعيش في بيئة إقليمية مشتعلة، ويمر بضغوط اقتصادية صعبة، والبطالة تتفاقم، والثقة تتراجع، والبيروقراطية تعيق الاستثمار. والسبب كما وضحه الاقتصادي أمارتيا سن “أزمة التنمية ليست نقصًا في الإمكانات، بل نقصًا في القدرة على ترتيبها”.
إن إقصاء الكفاءات، أدى الى تراكم الأزمات، دين عام يتضخم (تجاوز 46 مليار دينار)، ومشاريع مُؤجّلة، وخطط استراتيجية تُكتب ولا تنفيذ، واستثمارات تخرج، وجامعات تتآكل، وخدمات تتراجع، وثقة شعبية تهبط، وبعض القيادات التنفيذية تُكرر خطابًا بلا أثر. وهنا نجد ان توني جودت يلخص لنا الحالة بقوله “الأمم تنهض حين تتصالح مع فكرة أن الكفاءة ليست رفاهية، بل ضرورة وجودية”.
ومع ذلك، ما تزال بعض المؤسسات تختار أنصاف القادة، بينما يزداد إحباط الكفاءات الأردنية اتساعًا وعمقًا. وهذا ما وصفه باومان حين قال “الحداثة السائلة لا تحتمل أنصاف القادة، ولا تقف طويلًا مع من لا يمتلكون المعرفة”.
في المقابل، تُظهر تجارب دول مثل ألمانيا أن النجاح يبدأ بالاختيار الصحيح. فقد شددت ميركل، على أن “القيادة مسؤولية أخلاقية تفرض أن تختار الأكفأ، لا الأقرب”.
اما تاتشر، كانت ترى انه لا يمكن لأي حكومة أن تنجح إذا لم تُسند القرارات إلى من يعرفون حقًا كيف تُدار الأمور.
كما وحذّر تشومسكي من ان “المجتمعات التي تستبعد الخبراء تحكم على نفسها بأن تعيش في دائرة من الأخطاء المتكررة”. والسؤال هنا متى نتوقف عن تكرار الأخطاء؟
اليوم، من المفروض ان ننظر الى الإدارة، كفلسفة في رؤية الإنسان والمجتمع والواجب. ان غياب البعد الفلسفي العميق في الإدارة والتخطيط، يشكل أزمة في الفكر الإداري الأردني.
فالإدارة الأردنية، التي كانت قلعة متينة ومدرسة اقليمية قبل عقود، تعاني اليوم في الكثير من مفاصلها، فأصبحت تخاف من المختلف والمبدع، وتفضّل المتشابه والمطيع.
فالأردن اليوم يخسر معاركه الكبرى بصمت، معركة التعليم، ومعركة البحث العلمي، ومعركة الكفاءات، ومعركة الاستثمار، ومعركة الثقة. إنها مأساة الإنسان الذي يريد أن يخدم وطنه، لكنّ وطنه لا يمنحه المساحة ليكون.
ومع ذلك، يبقى الأردن قادرًا على النهوض، لأن لديه رؤية ملكية واضحة، ورسائل وخارطة طريق مكتملة لبناء دولة حديثة. فالتحدي ليس في الرؤية، بل فيمن يطبقها.
خارطة طريق تبدأ من التعليم وتنتهي بالاقتصاد، مرورًا بإصلاح الإدارة العامة، وحماية الكفاءات، ومحاسبة المقصرين، واختيار رجال دولة لا رجال مجاملة.
إن تنفيذ خارطة الطريق، لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى خطوات واضحة، إعادة بناء التعليم على فلسفة واضحة وثابتة، وتشكيل لجنة ملكية موثوقة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية في الميدان ترفع تقاريرها للملك مباشرة، ومساءلة دورية، وإلزامية للقيادات، وتقرير تجيب عن، ماذا تحقق؟ وماذا لم يتحقق؟ ولماذا؟ ووقف تدوير الفشل، وإنهاء عصر العلاقات، وحماية الكفاءات، والاستماع إلى أصحاب الخبرة، لا إلى أصحاب المصلحة، ووقف اقصاء وهجرة الكفاءات فورًا، واحداث تغير في الفلسفة الإدارية التي تنتج الدولة الحديثة.
المشكلة اليوم، ليست في الرؤية، ولا في الإرادة، او في الموارد، بل في الطبقات الإدارية التي تُمسك برقبة القرار وتخشى التغيير، ولا تتملك الجرأة على التنفيذ.
فالمعركة اليوم فكرية وأخلاقية قبل أن تكون اقتصادية أو إدارية. وللخروج منها نحتاج إلى ثورة هادئة في العقل الإداري، تعيد تعريف الجدارة، وتُعيد الاعتبار للخبرة والنزاهة، وتحمي الكفاءات، وتُحاسب المتلاعبين، فكما كتب تولستوي “لا يكفي أن تريد، بل عليك أن تبدأ”. والبداية الحقيقية في تفكيك العقد الداخلية، لا في البحث عن حلول خارجية.
فإن فعلنا، فإن كل أزمة ستصبح فرصة، وكل ضيق أفقًا، وكل تراجع إمكانية للنهوض. وعندها يكون الفارق بين الأردن الممكن والأردن القائم ليس بالموارد، بل بإدارة الموارد.
فمن حق الوطن أن يُدار بعقولٍ تفكر وتبادر، لا بأيادٍ تكتب تقارير عن إنجازاتٍ لم تحدث في الكثير من الاحيان.
الأردن، بقيادته الهاشمية، وبعزيمة الأردنيين المخلصين، قادر على تجاوز الازمة.