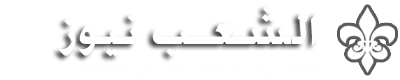الحرب كصراع لغوي ___ عمار علي حسن
الشعب نيوز:-
*أديب ومفكر مصري
لم يكن نصر بن سيـــار يجافي الحقيقة حين قال: “وإن الحرب أولها الكلام”، كما كان تساؤل ميشيل فوكو مبررا حين قال: هل ينبغي قلب العبارة التي تقول إن الحرب سياسة لا تعتمد وسائل السياسة لتصير إن السياسة حرب لا تعتمد الوسائل نفسها؟ ثم يجيب: “إذا أردنا أن نبقي على الفصل بين الحرب والسياسة فربما وجب أن نقول، بالأحرى، إن هذا التعدد لعلاقات القوى يمكن أن يعبر عنه ـ في جزء منه وليس في مجموعه مطلقا ـ في صيغة الحرب أو في صيغة السياسة، فهاتان استراتيجيتان متباينتان، ولكن يمكن لأحدهما أن تحل بسرعة محل الأخرى، لضم علائق القوة التي تطبع اللاتوازن والتنوع والتوتر وعدم الاستقرار”، وفي هذه العلاقة المتبادلة تحضر اللغة من أوسع الأبواب.
فلا يمكن للحرب أن تتفادى الاستعارات، طالما أن فيها من الحمولات الثقافية والمعنوية والأيديولوجية والدعائية بقدر ما فيها من الموجودات المادية المتعلقة بالسلاح والإمداد والخطط القتالية والتدريب. ويدرك القادة العسكريون التاريخيون هذه المسألة جيدا، لذا يحضر المجاز بشدة في خطاباتهم التي تسبق الحرب، أو يطلقونها أثناء جريانها، وحتى بعد أن تضع أوزارها، وهم يعظمون النصر، إن ظفروا به، ويقللون من شأن الهزائم إن سقطت على رؤوسهم.
فالمقولة الرئيسية التي تحكم النظر إلى الحرب في أغلب الأدبيات التي تناولتها، والتي أكدها الجنرال البروسي كارل فان كلاوزفيتز ترى أن الحرب هي سياسة تُقام بوسائل أخرى. وهذه المقولة تحمل استعارة واضحة، إذ إنه بها ينظر إلى السياسة كصفقة تجارية، تحتمل الربح والخسارة، وبذا يمكن تبريرها وفق شروط المنفعة، وليس طبقا لأي مبدأ أخلاقي. وعبارة غارقة في المجاز مثل “الجيوش تزحف على بطونها” التي أطلقها نابليون بونابرت، حكمت بعض العقائد والاستراتيجيات العسكرية زمنا، رغم أن هذا القول قد يبدو صحيحا من ناحية ما يتعلق بالإمداد والتموين أثناء الحرب، لكن القوات المسلحة تحتاج إلى ما هو أكثر وأبعد من القوت كي تبدأ وتواصل عملياتها، وفي مطلع هذا “القوام الفكري” الذي يخاطب العقل، وليس الوجدان أو الجسد، ومنه بالطبع “العقيدة العسكرية”.
وهناك استعارة تربط الحرب بالجسد، حيث نظر فرويد إلى الحرب بوصفها ظاهرة مرضية، ودلالة على عدم نضج نفسي لشعب أو حضارة ما. وربط كينيث والتز بين الحرب والطبيعة البشرية، وذلك وفق رؤية تمتزح فيها التصورات النفسية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية والدينية، إذ إننا مخلوقات خاطئة، طُردنا من جنة عدن، ونميل بطبعنا إلى العنف، وتسيطر علينا الرغبة في الموت، ونحن الحيوانات الوحيدة التي تقتل أبناء جنسها، ولا تمتلك رادعا يمنعها من ذلك”.
في الحقيقة ليست الاستعارة وحدها التي تُستخدم في مجال الحرب، إنما حيل وتقنيات بلاغية أخرى، فعلى سبيل المثال قام توين فان دايك في كتابه “الخطاب والسلطة” بتحليل الاستراتيجيات البلاغية الكلاسيكية في الخطاب السياسي لرئيس الوزراء الإسباني أزنار الذي برر فيه اشتراك بلاده في الحرب على العراق عام 2003، وأراد حشد الدعم الجماهيري لشرعية قراره، الذي كان يواجه وقتها بمعارضة ملموسة.
وقد قدم أزنار في خطابه هذا نفسه ووجهة نظره إيجابيا، بينما قدم الآخر سلبيا، إلى جانب عدد من الخدع والتقنيات المألوفة، كتوظيف الأرقام والحقائق، وسياسة إجماع الرأي، وأسلوب الموازنات، ومفاهيم الضرورة، وآليات التبرير، لربط الفعل السياسي بالحدث السياسي، وتضمين بعض المعارف السياسية في خدمة الواقع الجاري.
لكن الاستعارة كانت حاضرة بشدة في الخطاب الرسمي الأمريكي الذي برر الحرب على العراق، في سياق “الحرب على الإرهاب” ليبرز خطاب “القاعدة” في وجه الخطاب الأمريكي، وينقسم الخطابان المتصارعان إلى “خيِّر” و”شرير” أو “بطل” و”وغد”، وفي كل رواية للطرفين كان هناك دوما بطل وجريمة، وضحية وشرير، ففي حكاية الدفاع عن النفس، يمثل البطل والضحية شيئا واحدا، وتقدم الولايات المتحدة نفسها إلى الآخرين على أنها الدولة المعنية أساسا بمحاربة الإرهاب. أما الشرير، فإنه في الحكايتين معا نذل دائما وغير عاقل، ولذا لا يمكن للبطل (الأميركي) أن يتفاهم مع الشرير (العربي)، بل عليه أن يحاربه ويهزمه هزيمة منكرة، أو يقتله وينهي وجوده.
لم يكن خطاب الأمريكان خلال الحرب على العراق عام 2003 مختلفاً عن الخطاب الغربي الذي ساد طيلة الحرب الباردة، والذي قسم الأشياء إلى “أبيض” و”أسود” ولم ير ما بين اللونين من درجات عديدة، وانعكس هذا على الحرب الفيتنامية، حيث كان يتم تصوير الفيتناميين عادة باعتبارهم ساديين وروبوتات وشيوعيين بلا قلب، لا يحترمون الحياة الإنسانية، وهي استعارات مزيفة تخفي حقائق أن الفيتاميين كانوا بشرا عاديين، تحدوهم مشاعر الحب والكره، والأمل واليأس، شأنهم شأن سائر البشر.
هنا تحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قبيل الحرب على العراق عن “ضرورة إخراج الإرهابيين من جحورهم”، ليجعل صورة “الشر” الذي تجب محاربته بكل الطرق، تستقر في أذهان الشعب الأمريكي، بل في أذهان الكثيرين في العالم، ممن آمنوا وقتها بأن التقاعس عن محاربة الشر عمل غير أخلاقي، وأن استعمال كل الوسائل في الحرب على الأشرار مباحة، وهي مسألة متعارف عليها في الحروب، وفق المقولة ذائعة الصيت: “في الحب والحرب كل شيء مباح”.
واستعمل الأمريكيون قاعدة استعارية تقوم على “التماثل” حيث تمت مقارنة القاعدة، كتنظيم إرهابي يرتب جرائم بشعة، بما يُقدم صدام حسين على فعله، وظهرت مقالات وتصريحات تتحدث عن علاقة الديكتاتور العراقي بالإرهاب، أو استعداد الإرهابيين للرحيل إلى العراق ليتخذوا منه أرضا لقتال الغرب، أو احتمال أن يمدهم صدام بسلاح غير تقليدي يصلون به إلى الولايات المتحدة، وهنا تم استعمال استعارة تمثيلية أخرى، حيث أصبح الإرهابيون بديلا لصواريخ بعيدة المدى لا يمتلكها صدام.
وبرز في هذا المضمار كتاب جورج لايكوف “حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل”، الذي يؤكد في مستهله أننا نمضي في الحياة مكللين بالاستعارة عطفا على كتابه الآخر “الاستعارات التي نحيا بها”. فالاستعارة في حرب الخليج تم استعمالها لبناء استدلال على تمرير الهجوم على العراق، وفي إخفاء الوجه البشع للحرب، حين تعبث بمصائر الشعوب والدول.
لقد دخلت الولايات المتحدة الحرب مدججة بـ “ترسانة استعارية”، استعملت عبارات من قبيل “إعادة ترتيب المنطقة” و”الحرية للعراق” و”كسر الطاغية” وسط خطاب ينظر إلى السياسة بشكل عام على أنها “صفقة”، لا يتم التفكير فيها إلا من خلال منطق الربح والخسارة الاقتصادية، فهذه حرب مربحة، ومهما تكلفت فعوائدها مضمونة، لاسيما أن العالم كله كان موقنا بطغيان صدام واستبداده على شعب العراق، ورغبته العارمة في الاستحواذ منذ احتلاله الكويت في 2 أغسطس 1990.
هنا تنزاح كل الفظائع من أمام عيون الرأي العام، لتبقى الحسبة التجارية الباردة، بكل إغراءاتها، ويبقى أيضا الوعد الذي تجلي في تأكيد بوش أن الحرب تؤذن بميلاد نظام عالمي جديد، وشراكة بين الأمم، وتبقى ضآلة التكلفة في الأرواح مقارنة بحرب فيتنام، والتي جعلت بوش يصنع استعارة جديدة بعد سقوط بغداد بقوله: “لقد تخلصنا من متلازمة فيتنام”، وجعلت خبراء استفادوا مما جرى في المعركة ينتجون استعارة أخرى حين وجدوا أنه من المفيد للجيش الأمريكي أن يعرف أكثر عن شعوب الدول التي يريد غزوها، وهي نظام التضاريس الإنسانية، لأن بعض الحروب جوهرها ثقافي، أو أن الثقافة تكون أحيانا أهم عنصر فيها، وركيزة لها.
وفي ركاب هذه الحرب تم استعمال حادث نسف برجي مبنى التجارة العالمي في نيويوك يوم 11 سبتمبر 2001، في حشد استعارات متوالية نظرت إلى البنايات على أنها رؤوس، والمجتمع على أنه بناية، والأمن احتواء، والأمة شخص، ليتم تصوير العراق على أنه “صدام”، وطالما أنه شرير فبلده شرير بالتبعية.
ويحلل لايكوف بلاغة هذه الحرب ليبين كيف يتبارى السياسيون في استخدام الاستعارة لتزييف الوعي، وقلب الحقائق، وتمرير الجرائم والقتل والإبادة، وبذا تقتل الاستعارة بدم بارد، تحت أغطية وأردية من العبارات المستعارة التي تحيل القتل إلى تحرير، والدمار إلى بناء، وهي مسألة طالما تكررت في التاريخ الإنساني كحيلة من السياسيين كي يبرروا فظائعهم، إذ لا يمكن لأي منهم أن يعترف بأنه ذاهب ليغزو ويقتل ويدمر ويحتل، وأنه سيصحب معه الألم والموت وتقطيع الأوصال والتشريد والظلم والقهر، إنما من الطبيعي أن يغلف فعلته هذه بخطاب إنساني يزعم فيه أنه فاتح، ومنتصر للحق، وساعي إلى الخير، ورسول للحرية، ومكافح في سبيل تمدين الشعوب الهمجية، أو الأخذ بيد الدول المتخلفة إلى التقدم. وتوسعت الإمبراطوريات في كل الأزمنة وفق هذا المنطق، وأنتجت استعارات تواكب زحف جيوشها إلى مختلف البلاد.
لم تسلم الكتب المقدسة نفسها من توظيف المغرضين لبلاغتها، في تأويلات فاسدة، كي يبرروا القتال، وهي مسألة إن كانت ظاهرة بشدة في أدبيات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والعنيفة والإرهابية التي توظف الإسلام في تحقيق أهدافها، فإننا نراها حاضرة بقوة في “الحروب الصلبية”، وفي توظيف “الكتاب المقدس” لتبرير الاستعمار، بل تبرير العذاب الأليم الدائم والمقيم لشعوب بأكملها، بل وحتى إبادتها أحيانا.
ولا تقتصر الاستعارة في مجال الحرب على العبارات، إنما تمتد إلى الصور والرموز، فتنظيما “القاعدة” و”داعش”، اتخذا “راية سوداء” تسبق مقاتليهم في المعارك التي يخوضونها، زاعمين بأن راية الرسول محمد (ص) كانت “سوداء”، ثم ظهر تنظيم في العراق مثلا، بعد انكسار داعش على أرض الرافدين، يحمل “راية بيضاء” يتوسطها رسم لأسد. وكان الفرنجة يرفعون “الصليب” أثناء زحفهم الاستعماري على الشرق، بعد أن وظفوا استعارات لفظية حاشدة صورت العرب والمسلمين على أنهم “برابرة” و”كفرة” بينما هم كانوا “المخلصون” و”المؤمنون”، وقد جاء بوش الابن ليستعمل لفظ “البرابرة” قبيل الهجوم الأمريكي على أفغانستان في أكتوبر من عام 2001، قاصدا بهم حركة طالبان والقاعدة، ووقتها عاد البعض إلى استعارة نبوءة نوسترادموس الشهيرة التي توقع فيها حدث 11 سبتمبر والحرب التي تقوم بسببه، والتي قال فيها: “نار تزلزل الأرض، تخرج من مركزها، ستسبب هزات حول المدينة الجديدة، وستتصارع صخرتان كبيرتان لفترة طويلة وستلون أريثوسا نهرا آخر بالأحمر”.
ويكون المتصارعون في الحروب بحاجة ماسة إلى المجاز، ليس فقط في الدعاية أثناء المعركة، حيث اللغة ذات الجرس والإيقاع المدوي، الذي لا بد أن يجاري دقات طبول الحرب، إنما أيضا في الإدعاءات التي تعقب توقف القتال، ويبدأ كل طرف في رواية ما جرى من وجهة نظره، التي تخدم مصالحه، ويسعى إلى إقناع الشعب بها، وتسجيلها في كتب التاريخ.
ولعل الشاعر الكبير محمود درويش قد تمكن من التعبير عن هذه الحالة في روعة وإيجاز حين قال:
“مجازا أقول: انتصرت
ومجازا أقول: خسرت
ويمتد واد سحيق أمامي
وأمتد في ما تبقى من السنديان
وثمة زيتونتان
تلمانني من جهات ثلاث
ويحملني طائران
إلى الجهة الخالية
من الأوج والهاوية
لئلا أقول: انكسرت
لئلا أقول: خسرت الرهان”
ويمتد حضور المجاز في الحروب إلى مساحات يندلع فيها قتال من نوع جديد، ليس حول وصف ما جرى، إنما في صياغة المصطلحات والتعبيرات المجازية، التي لا تلبث أن يذاع صيتها، ويرسخ وجودها، ويرددها الناس كمسلمة لا تقبل النقاش ولا الجدل.
فنحن مثلا حين نسمع كلمة “حرب” في زماننا هذا فإن أول صورة ترتسم في الذهن هي انطلاق نيران كثيفة من مختلف أسلحة القوات البرية والبحرية والجوية. ومثل هذه النار لا يمكن أن تكون باردة، إلا على سبيل المجاز. لكن نظرا لأن اندلاع مواجهة مباشرة بين القطبيين العالميين آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي المنهار صار ضعيف الاحتمال، في ظل رفض الشعوب الغربية لحرب أخرى بعد حربين عالميتين مدمرتين، ومع نتاج سباق التسلح الرهيب بين القوتين العظميين الذي وصل إلى مستوى “الردع” المتبادل، فقد ساد ارتياح لصك الغرب مصطلح “الحرب الباردة”، وتداولته الأغلبية الساحقة من الساسة التنفيذيين والدبلوماسيين والباحثين والكتاب في مختلف أنحاء العالم على أنه مسلمة، لا تقبل الجدل والنقاش، أو أن كثيرا منهم لم يفكروا أصلا في مراجعته.
فبينما أدارت واشنطن وموسكو حروبا بالوكالة، ومناطحة قوية بين أجهزة المخابرات، وصراع أيديولوجي حاد بين الليبرالية والشيوعية، كانت الحركة الدبلوماسية الدائمة، ومحادثات التسلح، والخطابات المتبادلة التي تتسم بها العلاقات المباشرة بين الشرق والغرب، توحي كلها بأن هناك ارتياحا لإضافة كلمة “الباردة” إلى “الحرب”، ولكل ما يرتبط بها من مفردات مثل “جليد” و”ذوبان” و”برود” و”صقيع” .. الخ، وجميعها استعارات مستقاة من أحوال المناخ والطقس إلى السياسة الدولية في أعلى صورها، كان بوسعها أن تلفت الانتباه إلى جمود العلاقات بين القوى الكبرى، وهي وافقت رغبة الغرب في هذه اللحظة.
وتعود جذور المركب اللغوي المجازي المسمى بـ “الحرب الباردة” إلى الأديب الشهير جورج أورويل أتى على ذكره في مقال نشره عام 1945 تحت عنوان “أنت والقنبلة النووية”، ليطرح نبوءة أخرى تضاف إلى تلك التي وردت في روايته ذائعة الصيت “1984”، يرى فيها أن حصول قوتين أو ثلاث على أسلحة ذرية سيكرس الاستبداد السياسي، وإصابة الشؤون الدولية بشلل، حيث ستصبح الهزيمة مستعصية على أي من هذه القوى، ومن ثم تدخل في حرب باردة طويلة. ويتطابق هذا إلى حد ملموس مع ما ذكره عام 1947 برنارد باروخ ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الدولية للطاقة الذرية.
وهناك من يرى أن المصطلح قد صكه الصحفي الأمريكي إتش. بي. سووب ودعمه والتر ليبمان، واصفا به حالة “اللاحرب” و”اللاسلم” التي استمرت بين القطبين المتناطحين، وقد تجنب كل منهما الصدام المسلح المباشر، مثلما تم اختباره في أزمة كوبا 1962 والحرب العربية ـ الإسرائيلية 1973، وأدار كل منهما العداء بطريقة مختلفة، منها سباق التسلح، ونشر الأيديولوجيات المتصارعة.
ويقلب جون لويس جاديس المصلح نازعا عنه مجازيته وكل ما تحمله من دلالات، ليرى أن الفترة التي تراوحت بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط حائط برلين ليست حربا باردة إنما هي “سلام طويل”.
ويوجد من أصاب هذا المجاز في مقتل، إذ إن ما دار بين القوتين العظميين لم يحمل أي برودة، إنما سخونة دائمة، انتقلت من المركز إلى الأطراف، ومن الأطراف الأصيلة أو الأصلية إلى الوكلاء. ففي إطار رعاية الاتحاد السوفيتي للأنظمة اليسارية عبر العالم، ومقاومة الولايات المتحدة لتمدد الشيوعية، سقط أكثر من عشرين مليون في حروب دارت رحاها في كوريا ولاوس وكمبوديا وفيتنام وأفغانستان، وفي الصومال وإثيوبيا وأنجولا وغيرها، وفي الانقلابات العسكرية التي وقعت بقارة أمريكا اللاتينية وحملت إلى السلطة نظم حكم دموية تلقت دعما ماليا وعسكريا من الولايات المتحدة، وكذلك في حوادث الحدود أو خطوط التماس الجغرافي بين المعسكرين المتناطحين، وجراء السجون والمعتقلات في أوروبا الشرقية، وفي الغزو السوفيتي للمجر وتشيكوسلوفاكيا، وفي ركاب كل هذا العدد من الموتى، تم تدمير البيئة وانتشار الأوبئة وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
وبذا يكون وصف الصراع العالمي على مدار نحو أربعة عقود ونصف بأنه “بارد” هو مجاز خادع، ساهم في تزييف الوعي، وينطوي على نوع من القصور الذاتي وفقدان التوازن، علاوة على أنه يساهم في تكريس نزعة المركزية الأوروبية التي تحدد وفق أحوالها ومصالحها وتقدير الغرب فقط ما إذا كان الوضع العالمي باردا أم ساخنا، علاوة على أنه مجاز فاضح لنوايا الغرب أو فهمه للآخر، ومدى عدم تعاطفه مع أحواله، وعدم إدراكه لمصالحه، واحترام حق شعوبه في السلام. فكل هذه الملايين التي سقطت خلال خمسة أربعين سنة، وكل هذا الدمار والخراب والتشريد والتهجير والتعذيب وتشييد تلال من الجماجم، لم يره أولئك الذين اعتبروا تلك الفترة أطول فترة سلام شهدها العالم منذ بسمارك، واصفين هذه الحروب التي انتقلت من أوروبا وأمريكا إلى قارات ثلاث هي: أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بأنها نزاعات دارت في المناطق الطرفية من العالم، وأن ما يستحق أن يُطلق عليه حرب هو ما يقع من قتال بين القوى الكبرى.
وفي ركاب هذا التصور أو الاتجاه السياسي والفكري “كان التلاعب باللغة والصور في المجال العام سببا رئيسيا في ذلك التشكك الذي يراه كثيرون ملمحا محددا لثقافة الحرب الباردة، مع أعمال الدعاية المستمرة ومناخ التجسس السائد والاستخبارات المضادة والتآمر الدولي، ولم يكن هناك سوى القليل من الحقيقة التي يمكن أن يؤسس عليه المرء اقتناعاته الأيديولوجية”
وإمعانا في تكريس المجاز الغربي حول “الحرب الباردة” تم تجاهل الغرب للآداب والفنون التي عبرت عن الصراعات المسلحة والمنافسات السياسية الحادة والتطاحن الاجتماعي الذي ساد في دول خارج أوروبا وأمريكا، والتي أنتجها أدباء عالمثالثيون تفاعلت مضامينها مع البنى السياسية والعسكرية والفكرية والثقافية واللغوية والدبلوماسية لتلك الفترة، ويخلص من يطلع عليها إلى أن فترة “الحرب الباردة” كانت ساخنة بمعايير دول ومجتمعات غير غربية.
وما في الحرب من قسر وإجبار وإرغام وعنف انتقل في العقل الأوروبي مجازا من ميادين القتال الموزعة على خرائط العالم غير الغربي إلى عالم اللغة، الذي يمكن فيه أن يمارس عنفا من نوع آخر، فتم فرض اصطلاح “الحرب الباردة”، ونسجت حوله عبارات كانت ترجمة لنيات وحسابات وإدعاءات ومزاعم، لا تساق من فراغ إنما لتحقيق أهداف محددة، استقرت في يقين الغرب بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وفرضها على الجميع، مثلما فرضت الولايات المتحدة بعد انهيار غريمها الأول الاتحاد السوفيتي مصطلح “النظام الدولي الجديد”. ومع أن المصطلحات ربما تكون قد تغيرت من “التدخل الحميد” إلى “تغيير النظام”، ومن “الخطر الأحمر” إلى “الرعب الكوني” فإن المشهد السياسي ظل على حاله، متمثلا في قوة تسعى إلى الهيمنة وعالم يتمرد بعضه على الوضع السائد ويقاومه.
يبقى المجاز الذي لم يسع من صكوه إلى مخاتلة أو خداع وكان من نتاج ما تسمى “الحرب الباردة” هو “سباق التسلح”، الذي ظهر في سياق التنافس بين بريطانيا وألمانيا في الفترة من 1900 إلى 1914، هو الذي قاد إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وذاع صيت المصطلح حين كان الصراع على التفوق في تصنيع واقتناء السلاح بين موسكو وواشنطن على أشده . وكلمة سباق مجازية تعني أن التقدم في حيازة السلاح من قبل طرف يقابله مسارعة من الطرف الآخر لحيازة أسلحة أكثر ممن يسبقه، وولدت في ركابها مجازات أخرى مثل تعبير “حرب النجوم” الذي أطلقه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، ووصفه بأنه أوسع وأعلى من أن يبلغه الروس أو يتجاوزوه.
في المقابل فإن “الحرب” تمت استعارتها لمجالات لا علاقة لها بأي مسائل تخص المعارك والقتال، مثل مصطلح “حرب الروايات”، الذي حين نسمعه، ينصرف الذهن على الفور إلى الوصف المتناقض لواقعة واحدة على ألسنة ساسة في لحظة صراع ما. ولهذا نسمع دائما روايتين مختلفتين في كثير من الأحيان، واحدة للسلطة وأخرى للمعارضة، وواحدة للشرطة وأخرى للمتظاهرين مثلا، وواحدة للمنتصر وأخرى للمهزوم في الحروب، وواحدة للمستعمًر وأخرى للمستعمًر .. وهكذا.
وفي أغلب المراحل كانت رواية السلطة مشبعة بالأكاذيب، فإن وجدنا رئيسا أو وزيرا يتحدث، ويقسم بأن ما يقوله صدق فعلينا أن نسمعه بحذر، وننظر جيدا إلى عينيه، قبل الإنصات إلى صوته المشبع بالمجازات، والغارق في المسكنة، أو الذي يتظاهر فيه بالشجاعة والقوة، وهو أضعف من ريشة في مهب الريح.
وحين نسمع استعارة “حرب الروايات” تأتى إلى الذهن إمكانية أن نقلب المصطلح، كنوع من المشاكسة اللغوية، فيصير “رواية الحرب” وبالتالي نجد أنفسنا أمام مسار طوعي معتاد هادئ يسير، إذ إن الروايات التي جعلت من الحروب، بمختلف درجاتها وأنواعها، مادة لها أصبحت كثيرة وتراكمت على مدار الزمن لتشكل تيارا أدبيا صار البعض يطلق عليه “أدب الحرب” والذي ساح في ألوان أدبية شتى إلى جانب الرواية مثل الشعر والقصة والمسرحية، وصور المعاناة الإنسانية وقت القتال، أو رسم مسار المعارك وأرخ لها، أو حاول أن يمجد النصر، ويخفف من وطأة الهزيمة، وهكذا. وهناك أيضا ما سمي بـ “أدب المقاومة” والذي ضاق عند البعض ليحصره في المقاومة المسلحة، واتسع عن آخرين ليشمل ألوان المقاومة كافة، سلمية ومدنية ونفسية.
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد المتداول في الأدبيات السياسية حول رواية الوقائع بطرق متناقضة، ولا أدب الحرب وأدب المقاومة، ولا السرديات الكبرى التي تمجد تاريخ أمة، أو تحكي حكايتها الوطنية، وتنعش ذاكرتها القومية، وتدافع عن هويتها، بل تعداه الآن إلى حديث عن “حروب السرد الروائي” التي تعني التنافس الحاد بين الكتاب ودور النشر والدول في مجال كتابة الرواية وإصدارها وتوزيعها، والقتال الأشد ضراوة في سبيل حصولها على جائزة محلية أو إقليمية أو دولية، في سعار شديد، دخلت عليه قوى السوق الرأسمالية بكل آلياتها، حتى أننا بتنا نسمع عن أن أصحاب دور النشر هم من يحسمون التنافس على الجوائز الأدبية، وليست القيمة الفنية للنص ولا حتى التاريخ الأدبي لصاحبه، لأن الجائزة وقتها ستؤدي إلى مزيد من توزيع الرواية الفائزة، ما يعني أرباحا أكثر في جيوب الناشرين.