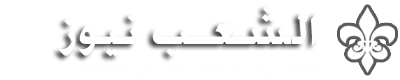تقاطعات رؤيَوِيّة واستراتيجية السّرد في “نطفة في قلب غسّان كنفاني” للرّوائيّة زينب السّعود
الشعب نيوز:-
رؤية: وداد أبو شنب
“نطفة في قلب غسّان كنفاني،” رواية للروائية زينب السّعود، والصادرة عن دار الأهلية 2024.
رواية في ثناياها أصداء كثيرة لأعمال سابقة، كصوت محمود درويش الصريح، وتميم البرغوثي وأصوات من الثقافة الشعبية، كما تستقبلنا شخصية ندى: الشخصية الأولى في هذا العمل، والتي تحيلنا إلى رواية “في قلبي امرأة عبرية” للدكتورة خولة حمدي، والعنوان يحيل أيضا إلى رواية أدهم الشرقاوي “نطفة”، هي مجرّد أصداء وتقاطعات رؤيوية سببها كون الرواية إنسانية بالدرجة الأولى وهي من أدب المقاومة. رواية تحتوي في داخلها أصداء ورؤى كثيرة تجسّدت في نصوص موازية أدّت الغرض تماما، نحو: “المقطوعات الشعرية وكلّ الأغاني الواردة”: “من جبل النار طلع الثوار/طلعوا والفجر عالآفاق/يا نابلس يا باسلة خلي المراجل شاعلة/ولتعصري آمالهم برحى الرجال الثايرة” ص58، أو تجسدت في أحداث أومواقف؛ أصداء وأصوات متعدِّدة من هنا وهناك في قلب الرواية، أتقنت الروائية زينب السعود لعبة السرد، ولعبة التأريخ ولعبة الوصف لإنشاء سردية يألفها القارئ، قريبة من روحه، لكنها لا تشبه أي عمل سبقها.
الرواية من فصلين، فصل هو أساس الرواية وهو الفصل المقصود، والذي أوجدت فيه الروائية ثغرات ليملأها متلقيها بتوقعات قد يعيد تعديلها فيما بعد، مثل كلّ ما يدور حول أمّ غسان كنفاني من غموض وتكتُّم، وسلوك غسان ضعيف الوطنية أو عديم الانتماء أو المنفصل عن “الجغرافيا”.. أو كرهه غير المبرّر لاسمه في الوقت الذي يفخر كلّ من اسمه غسان بوجه الشبه بينه وبين الأديب الراحل. تركت فراغات موعزة لمتلقيها بالبحث والتخمين ضمنيا، لكن علنا أخبرته في إحدى العتبات قائلة: “في هذه الحكاية لا تبحث عن شيء منطقي، لا تحاول أن تكتشف الحلقات المفرغة، هذه ليست كل القصة… هناك جزء مفقود من القلب، عالق في حاجز طيّار”ص5. وهذا نوع من المراوغة يسلكه المرسل، ونوع من التواطؤ بين المرسل ومتلقيه.
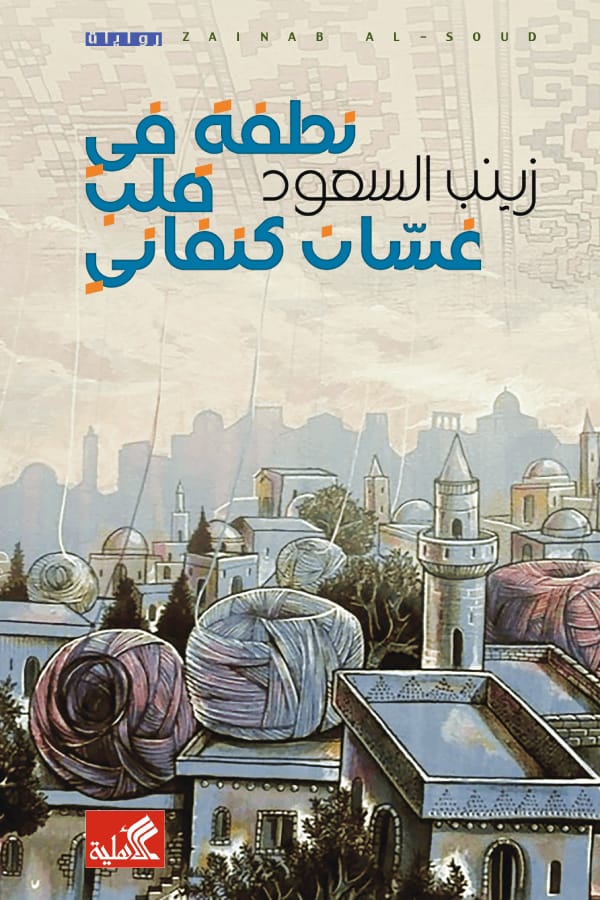
يبدأ الفصل الأوّل من الرواية بتساؤل ندى عن سبب وكيفية وجودها في ذلك الحمام الزنزانة، من زجَّ بها إلى هناك؟ وينتهي بإعلانها عن كتابة أوراقها مع توصية ألا تصل إلى غسان!! وما بين البداية والنهاية حياة تعرضها زينب سعود على لسان ندى كسارد أول، وباستخدام تقنية الفلاش باك “اللواحق” على مسار سردي طويل متعدِّد المكان ومتشظّي الزمن، فصل مكان بدايته هو مكان نهايته. بينما يأتي الفصل الثاني بزمن خطي أحادي يبدأ بمناجاة غسان مع نفسه وبداية رحلة العذاب بعد استلام أوراق ندى التي كان من المفروض أن تصل باسمة صديقة ندى، وأن يستبعد هو تماما.
يأتي الفصل الثاني والذي يمكن اعتباره “ملحقا” على لسان سارد آخر من الدرجة الأولى أيضًا، ليملأ الفراغات التي تركتها ندى/زينب، فتحدَّث عن أمِّه وأبيه وعن حبِّه لها -ندى-وعن اسمه الذي كرهه لسبب وجيه: كيف لشخص يختار زوجة يهودية أن يسمي ابنه باسم كاتب المقاومة “غسان كنفاني”؟؟ يرى في هذا نفاقا لم يتّسع له قلبه.
في هذا الفصل الثاني، تستدعي الروائية لوحات الوعي، واستدراك الإنسان الفلسطيني التائه لوضعه ولحقيقة الصورة الماثلة أمامه، وزيف ما كان يعتقده، تطرح الروائية عبر رؤى غسان رؤى قد طرحتها من قبل كأمر واقع مفروغ منه، لم يكن غسان يدركه، وها قد أدركه الآن، تدعم الروائية فكرة الوعي واليقظة التي كانت ترسلها تارة عبر رؤى ندى وأخرى عبر رؤى غسان كما في مشهد انتقالهما إلى نابلس من أجل الولادة: ص.ص56-58 وص.ص60-67. لتبثّ في متلقيها الوعي الحقيقي بالقضية وبحقيقة الاحتلال؛ وإلى جانب تيار الوعي هناك صراع وجودي وأسئلة وجودية يطرحها كل من استلبت منه رقعته الجغرافية: أسئلة نحو لماذا يسكت الله عن هذا القهر ص164.الفصل الثاني ملحق أو رسالة مراوغة لشد انتباه القارئ أكثر مفادها: هذا الفصل حلقة وصل بين هذا الجزء والجزء القادم!! فهل تعلن زينب عن جزءٍ ثانٍ للرواية؟؟
العتبة الأولى لهذه السردية الروائية هي العنوان، وهو جدلي جدّا حاله حال عناوين روايات الروائية زينب السعود، هو بطاقة إبهار محملة بتساؤلات كثيرة جدّا، أغلبها يدور حول الكاتب والروائي الفلسطيني الراحل غسّان كنفاني، لا سيما أنها استعارت مقولة له كعتبه في بداية الرواية، لترسيخ فكرة حضور الروائي غسان في صلب العمل، وما أن يلج القارئ إلى هذه السردية/الرواية، حتى يتفاجأ أنّ المحتوى ليس له علاقة البتة بالروائي غسان كنفاني، إنما هو اسم مركب لشخصية مزدوجة الجنسية تمقت اسمها، وما أن يصل إلى الفصل الثاني حتى يدرك أنّ اسم المسمّى إنّما كان تيمُّنًا بالكاتب فعلا!!
قامت الروائية باتّباع أساليب الحجاج من أجل استمالة المتلّقي وجعله يصدق كلّ ما جاء في الرواية، ومن أهمّ تلك الأساليب: الاحتمالية والتفاعل مع الواقع واستعمال اللغة بصور بلاغية عالية، كلّ ما في الرواية من قرائن يوحي بحقيقة الأحداث، وذلك باستخدام وقائع مثل حرب السابع من أكتوبر والخيَم والانفجارات والحواجز، واستخدام أسماء مثل رامز أبو دقة والذي يحيل إلى عدّة أبطال من هذه العائلة القاطنة في القطاع وآخرهم المصور الشهيد سامر أبو دقة، واسم غسّان كنفاني، مم يثير فضول المتلقي: أهناك تقنية غرائبية باستحضار الروائي غسان كنفاني على سبيل المثال؟ وأشهر هذه القرائن اسم ندى الذي اخترته الروائية اقتباسا من الاسم الكامل للشاعرة الشهيدة هبة أبو ندى، وكانت قد استعارت من شعرها في متن الرواية ص22: “قالت هبة الشاعرة التي لم تمهلها مدافع الميركافا لإنهاء قصيدتها الأخيرة، قالت: “إنّ غزّة أخرى تبنى في الجنة”، وجاءت ببيتين شعريين كعتبة قبل الفصل الثاني. فالروائية توجِّه متلقيها لاستقبال رواية حقيقية كلّ ما فيها مقنع رغم سحر التخييل.
كما قلت فيما سبق، إن أحداث الرواية تسير في أمكنة واضحة المعالم، رسمتها بدقّة الروائية زينب السعود، مثل باذان ونابلس ص41، ولاحقا حيّ الياسمينة بعراقته ورائحته التي تكاد تصل إلى أنف المتلقي، حي الرمال في غزة وشارع صلاح الدين، وشارع عمر المختار، وكانت الروائية تصف الأماكن بعناية وتصفها بدقّة، لكن عند استحضار الوعي الحقيقي تستخدم مصطلح الجغرافيا نحو:
“لا أريد الخروج من جغرافيتي ص114 -على لسان ندى.
لقد كانت الجغرافيا هي السبب دائما ص188 -على لسان ندى.
أحببت تدفقها في حب ما تسميه جغرافيا الوطن ص201 – على لسان غسان.
على قدر ما كنت أكره ترديدها لكلمة الجغرافيا، أشعر الآن أنني متشبع تماما بها 213 -على لسان غسان
لماذا لم أعلن أنّني أيضا ابن هذه الجغرافيا وأنتمي لها؟213 -غسان
تدور بي الجغرافيا والمعجزات التي تحدث220-غسان:
تلك الأماكن مرسومة بدقّة، وأحداثها تتمثّل عبر زمن متشظٍّ تغيب عنه في غالبية مواضع الرواية الافتتاحية الزمنية “نحو: ذات صباح، أو في العام… أو منذ يومين، كما كانت تنتقل أحيانا من فترة إلى أخرى دون تقديم أو تلميح مثل: ص.ص 175 ذلك لأنّ فكرة الزمن ثابتة للفلسطيني، ويوم الصحوة أو الانتفاضة النهائية ستكون نقطة الانعطاف والتحوّل التاريخي والزمني، زمن متشظٍّ -تمثَّل في الاسترجاع أو الفلاش باك- كما وصفه الدكتور صلاح جرار في الغلاف الخلفي للكتاب: “تقوم الرواية على آلية الاسترجاع واستدعاء التفاصيل مع براعة في التصوير”. وهذا التشظّي يحمل كلّ معاني الثورة والتّمرد والانكسار والانبعاث والموت والحياة، تشظٍّ ينمُّ عن واقع غير متّزنٍ تنخره عفونة الجور والقهر.
رواية بعدة مسارات والهدف منها واحد، تطرح قضايا مختلفة بعرضها لقضية فردية (ندى أو ندى وغسان) داخل قضية سردية شعب كامل، فتسير الأولى في رحم الثانية سيرا قويما، أو تسير الثانية في قلب الأولى إلى أن تبلغ مبتغاها.
في الرواية رمزية عالية تفتح باب التأويل على مصراعيه، وفيها بياضات نصية لم تقم الروائية بملئها ليقوم القارئ الحصيف بملئها وفقا لخلفيته المتنوعة: ثقافيا وبيئيا وأيديولوجيا وتاريخيا و… وبالتالي يتجدّد النص وتُثرى إنتاجيته عدد مرات قراءته.