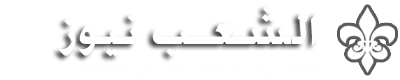واقعنا الاجتماعي لا يزال منجذبا إلى أيديولوجيات متصارعة
الشعب نيوز:-
الحوار مع د . عمار حسن علي يشكل إشكالية عبر حوارات ممتدة تزدهر ثم تُستخدم الاستخدام الذي يُثير الأجوبة، التي تُغني القارئ من ثقافة واسعة٠
نشير هنا إلى أنّ قضية الأيديولوجيا التي يثيرها سواء في الأدب أو في السياسية، هي قضية عالمية يقول فيها خوف المجتمعات حول العالم تحلّ الأيديولوجيات محل المعرفة، وهي مشكلة كبيرة وكارثة، على البشرية معالجتها بعيدًا عن التصعب حتى لا تصبح المعالجة ايديولوجيا جديدة٠
حاوره:
سليم النجار.
س: إلى جانب أنك كتبت أكثر من لون أدبي: الرواية والقصة والقصيرة القصيرة جدًا والمسرح والشعر والنصوص السردية عابرة الأنواع، يظهر في التعريف بك أنك أيضًا ناقد أدبي وباحث في علم الاجتماع السياسي، فهل هناك علاقة بين الحقلين الاثنين الأخيرين في نظرك؟
ـ هناك علاقة عامة بين النقد الأدبي والاجتماع السياسي، تتمثل في أن السياسة، كفعل يبدأ بالهم اليومي لمواطن بسيط يقطن قرية صغيرة نائية وصولًا إلي التدابير المرتبطة بالسلطة العليا، تحيط بكل شيء، ولذا من الطبيعي أن تحضر في النصوص الأدبية بأشكال متدرجة ومختلفة، خافتة في رواية أو قصة حتى لو كانت تنتمي إلى السرديات النفسية والذاتية البحتة وأدب الرعب، أو ظاهرة كما في “الرواية السياسية”، وفق تصنيف متعارف عليه.
ويجب على التأويل في الحالة الأولى أن يمارس دوره في استخلاص تأثير السياق العام على النص، وهو موجود بالفعل، لأن أي نص لا يولد في فراغ، كما أن منتجه يتأثر بالقطع بالبيئة التي تحيط به، والسياسة متماهية فيها، ومؤثرة عليها. وفي الحالة الثانية برصد وجود السياسة بمختلف تجلياتها وحمولاتها في النص، بغض النظر عن مستوى وحجم وعلامات هذا الوجود.
وهناك علاقة خاصة بين النقد الأدبي والاجتماع السياسي نراها ماثلة للعيان في النقد الثقافي والدراسات الثقافية والنقد الأدبي المنتمي إلى النظرية البنيوية التوليدية. فالاجتماع والسياسة معا هما من الحقول المعرفية التي تهتم بها الدراسات الثقافية إلى جانب علوم النفس والتاريخ والإعلام واللغة والأنثربولوجيا.
في كل الأحوال فإن إلمام ناقد الأدب بأحوال المجتمع، ومعاني السياسة وتدابيرها مهم له، ليحيط بالنص من شتى جوانبه، غير مقتصر على تحليل شكله أو مواطن الجمال فيه.
س : هل معنى هذا أن النص أي كان تصنيفه أدبي أو فلسفي، أو اقتصادي أو فكري، هو بالأساس نص سياسي؟
ج: الأمر يكون واضحًا وسهلًا في حال الكتابات الاقتصادية، فلا اقتصاد دون سياسة، ولا سياسة دون اقتصاد، هناك تلازم بين الاثنين، والفصل بينهما خطأ وخطل وتضليل، ويتعجب المرء من الذين يتحدثون عن تنمية في ظل موت السياسة أو تهميشها أو الاستهانة بها، ومن الذين يعتقدون أن الممارسة السياسة أشبه بالألعاب الذهنية والحركية التي لا تؤدي وظيفة في تحسين أحوال الناس المادية.
أما في النص الفلسفي فالأمر يتوقف على القضية التي يتناولها، فإن كانت فلسفة غارقة في التجريد، كتلك التي تثير جدلًا حول أمور ذهنية بحتة، أو التي تهتم بالمسائل الكونية، فإن السياسة تغيب، خصوصًا في تفاصيلها الدقيقة. يختلف الأمر في الفلسفات التي تحط على الأرض، وتنشغل بالواقع، وعذابات الإنسان المتعددة في الحياة، وكذلك ما يغنيه ويرضيه ويسعده.
في العموم فإن الفلسفة اليوم مشتبكة مع الأفكار والتصرفات المتعلقة بالعيش، بدءًا من الفرد وحتى الدولة وصولًا إلى العالم، ولذا فحضور السياسة فيها واضح، سواء أتت على ذكرها صراحة أو مستها من بعيد، أو دارت حولها، أو نظرت إليها كعنصر من عناصر الفهم والتحليل والتأويل.
وفي عالم الأفكار، تظهر السياسة كمبحث مهم، فتنتج ما نسميه “الفكر السياسي”، وحتى لو كانت الفكرة حول ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو لغوية فإن للسياسة بمعناها العام نصيب فيها، بغض النظر عن مستوى وحجم هذا النصيب.
يختلف الأمر بالنسبة للنص الأدبي، فهو نص فني أو جمالي بالدرجة الأساسية، حتى لو دار حول فكرة أو فعل سياسي. ومن هنا فإن حضور السياسة فيه يتوقف على نوعه، فنحن نعرف الرواية السياسية، والشعر السياسي، والمسرح، بطريقته المباشرة عالية النبرة، يمكنه أن يغرق في السياسة حتى أذنيه.
في كل الأحوال فإن السياسة تمثل بالنسبة لللأدب الحدث أو الواقعة، إذ لا يوجد حدث فني إنما حدث سياسي يعالج بطريقة فنية، كما قال نجيب محفوظ، والسياسة تحيط بالأديب لا يستطيع منها فكاكًا كما قالت الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل في الآداب.
س: بالنسبة لك كدارس للعلوم السياسية وباحث في هذا المجال ومنخرط في الحياة العامة تؤدي دورك، كيف تحقق هذا المعيار الذي يفصل بين هذا المجال، وبين كتاباتك الروائية والقصصية والشعرية؟
ج: ابتداء، لا يخلو نص من سياسة، بدرجة ما، كما قلت، وبالنسبة لي من الطبيعي أن تتسرب السياسة إلى نصوصي، لكنها ليست واحدة، فقد كتبت الرواية الواقعية الاجتماعية العادية والفجة، والرواية التاريخية، والرواية التي يظهر فيها التصوف كممارسة دينية وفلسفة، والرواية النفسية. لكن أرى أحيانًا أن بعض النقاد يقرأون نصوصي قراءة بيوجرافية، حسب تعبير الروائي والناقد الإيطالي، إمبرتو إيكو، لأنهم يذهبون إلى تأويل النص وهم يعرفون اهتمام صاحبه ودوره.
أنا لا أمارس السياسة على أنني سياسي محترف، إنما مثقف منتمي أو عضوي، حسب اصطلاح الإيطالي أنطونيو جرامشي، وهناك من يضعونني في هذا المقام فعلًا. لكن حين أجلس للكتابة أعرف النوع الذي أكتبه، فالاهتمام السياسي، خصوصًا في علم الاجتماع السياسي، يظهر في مقالاتي ودراساتي وكتبي، أما النصوص الأدبية فلها شروطها التي أحرص عليها، حتى لو كتبت رواية ما، قد يصنفها النقاد على أنها سياسية.
س: عطفًا على كل هذا، هل تشكل الأيديولوجيا إشكالية في السرد أو الشعر؟
ج: هناك أدب أيديولوجي بالفعل، لكنه أدب مصاب بالعطب، يمتد إليه بؤس الأيديولوجيا وعبثها، وتحوله إلى أدب دعائي ومنحاز، وتنزع منه العمق الإنساني، لاسيما إن حولته إلى منشور أو بيان سياسي.
وعلينا هنا أن نفرق بين حالة الأيديولوجيات التي تصاغ بطريقة أدبية، من حيث حضور المجازات والصور والحوار إن كانت هناك حاجة إليه، وبين حالة الأدب الذي يكتب ليخدم توجهًا سياسيًا أو فكريًا معينًا. فالأولى يمكن تفهمها، لاسيما أن الأيديولوجيات تستعير دومًا من الأدب بعض سحره وجزالته، لتكون أكثر جاذبية فتمارس دورها في اصطياد الأتباع. أما الثانية فمرفوضة، وقد جنت على الأدب كثيرًا، والدليل الأهم الذي يقدم في هذه الناحية هو الأدب الروسي الذي كتب قبل الثورة البلشفية بواقعيته الاجتماعية وطرائقه الفنية البديعة، وبين ما أنتج بعدها من أدب بائس كان مجرد أحد أبواق الدعاية التي تخدم الشيوعية.
س: لكن الرواية ليست جماليات فقط بل هي فكرة أيضًا، أليس كذلك؟
ج ـ لا تخلو رواية من فكرة، بغض النظر عما إذا كانت جديدة أم متداولة، مهمة أو تافهة، عميقة أم سطحية، مبهرة أم باهتة، لكن هذه الفكرة تُصاغ بطريقة فنية، ونحن لا نقدر قيمة الرواية على فكرتها فقط، وإلا أمكن ضغطها في مقال واحد، إنما على أسلوبها الفني، وبنائها، ولغتها، وقدرة شخصياتها على التعبير عن أنفسها، كل حسب ثقافتها ومهمتها وتطلعاتها، وما فيها من خيال وتخييل، عملًا بأن الرواية ليس مجرد انعكاس للواقع، إنما صياغة هذا الواقع بطريقة مغايرة، تلتزم بشروط الفن، وتعبر عن إدراك الكاتب لهذا الواقع وموقفه منه.
في كل الأحوال فإن الرواية أكبر من أن تكون مجرد وسيلة لتقديم فكرة، فهذا يصلح للقصص الوعظية الدينية والتربوية، إنما هي تشكيل معقد من عناصر مختلقة وواقعية، وإعادة صياغة حدث جرى أو متوقع أو متخيل عبر لغة تراوح بين الشاعري والتقريري، بل هي إعادة مجريات الحياة وترتيبها على نحو مغاير، بالإضافة إليها والخصم منها، أو اختراع جديد فيها مثل “العمى” لساراماجو و”الخالدية” لمحمد البساطي، بحيث تجعلنا قادرين على أن نرى أنفسنا ومجتمعنا والعالم حولنا، والكون أحيانا، من زاوية غير معتادة.
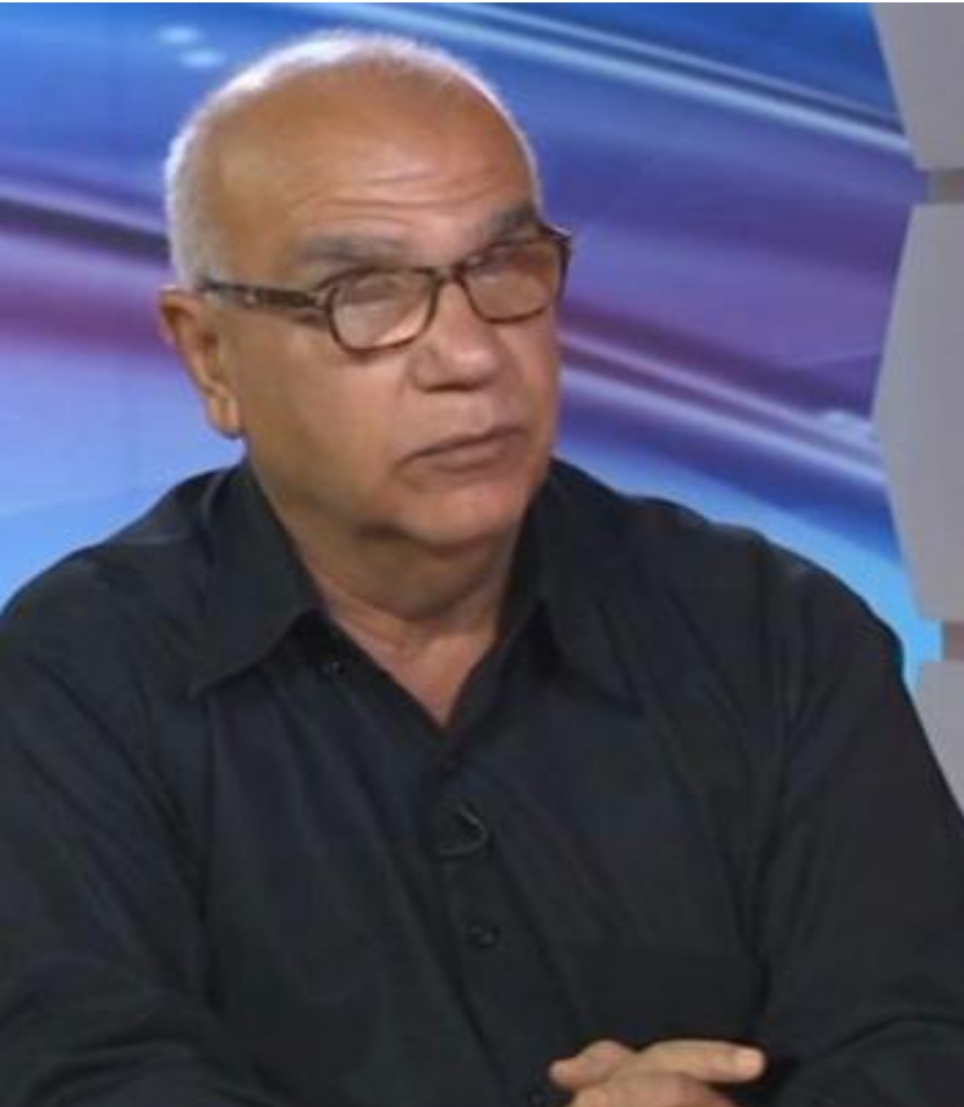
س: أنت تقول هذا رغم أن الواقع الذي تستلهم منه معظم الروايات العربية، في نهاية المطاف يبدو أيديولوجيا؟
ج : لا أنكر أن واقعنا الاجتماعي لا يزال منجذبا إلى أيديولوجيات متصارعة، إسلامية ويسارية وليبرالية، مع تفاوت حجم وجود كل منها في حياتنا الراهنة. ولا أنكر أيضًا أن بعض الروايات وقع مبدعوها في هذا الفخ، ووقع النقاد أيضًا فيه. فرأينا من يصنف الأدب على أنه رجعي أو تقدمي، برجوازي أو بروليتاري، إسلامي أو يساري أو يميني. لكن هناك روايات كثيرة، سواء منذ فجر الرواية العربية وحتى الآن، تجاوز كتابها هذا التصنيف الإكراهي، وآمنوا بأن الفن، ومنه الفن الروائي، يجب أن ينزع إلى أبعاد إنسانية، تسمو فوق الصراع الأيديولوجي الفج، ولا يجعل من الأدب مطية لخدمة تنظيم أو حزب أو نظام حكم.
وعلينا هنا أن نفرق بين انعكاس الصراع الأيديولوجي في الكتابات المباشرة من مقالات وتحليلات وتعليقات، وبين تسلله إلى الرواية، فالأول مفهوم مقصده، ومقبولة طريقته، لكن الثاني مرفوض وملفوظ.
وفي الواقع أدرك كثير من أدبائنا الفرق بين الحالتين، فبعض الشعراء والروائيين، بل كثير منهم، شرعوا أقلامهم في هذا الصراع من خلال كتابة المقالات الصحفية، ففرغوا في هذا شحنتهم وطاقتهم الكتابية، حتى لا تتسرب إلى نصوصهم فتفسدها، خاصة أن بينهم من أدرك أن القصة أو الرواية أو القصيدة لا تسعفه في أداء دوره ككاتب عليه أن يقول كلمته الآن وهنا وبلا مواربة، ولعلنا نستدعي في هذا المقام يوسف إدريس، الذي خاض معارك سياسية وفكرية عبر مقاله بصحيفة “الأهرام”، وحين لامه البعض على مغادرة القصة قال عبارته الشهيرة: “حين تكون أمتي في محنة لا تسألني عن شكل الكتابة”. في المقابل لم يرد نجيب محفوظ للمقال أن يسرقه من الإبداع الأدبي فاكتفى بزاوية أسبوعية صغيرة في “الأهرام” أيضًا.
وعلى المنوال ذاته قرأنا مقالات لتوفيق الحكيم، ولويس عوض، وإحسان عبد القدوس، وصلاح عبد الصبور، وأدونيس، وتركي الحمد، ومحمد الماغوط وغسان كنفاني ومؤنس الرزاز، والقائمة تطول. انخرط هؤلاء بمقالاتهم في الصراع الأيديولوجي، سياسيًا كان أو فكريًا، وفي الأحداث الجارية، وجنبوا إبداعهم هذا الأمر، وتفادوا سلبياته، حتى لو رققوه وخففوه وأطلقوه في ثنايا نصوصهم، العامرة بالفن.
نعم، كان هؤلاء يستجيبون في كتابة المقالات لوظيفتهم لكون بعضهم صحفيين أو ينتظرون مقابل مالي لمقالاتهم، لأن الأدب في بلادنا لا يكفي للعيش، لكن مقالاتهم جاءت معبرة بالطبع عن انتماءاتهم الفكرية، أو مواقفهم من السلطة السياسية اقترابًا وابتعادًا، موافقة ومعارضة، ممالأة وغبنًا.
س: ألا يحتاج البعض أحيانًا أن يصرخ من خلال النص فيأتي عاريًا زاعقًا ليؤدي بعض المقاصد؟
ج: أحيانًا يكون الغضب واجبًا، ويمكن للأديب أن يعبر عن غضبه هذا في مقال، والآن يمكنه أن يكتب منشورًا أو تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، لكن ماذا لو كان الغضب مسربلًا بحكاية أليمة تستوجب أن تستنهض الهمم، وتأتي الكتابة معبرة عن وجع؟ هنا يمكننا تذكر رواية “الطنطورية” لرضوى عاشور، أو بعض كتابات غسان كنفاني، ويمكننا أن نتذكر أيضًا أشعار أحمد فؤاد نجم ونجيب سرور.
أتذكر أن الروائي المصري محمود الورداني قال إنه عاب على “الطنطورية” أنها نص زاعق مملوء بالغضب والإدانة، ثم تراجع وأبدى أسفه لرضوى عاشور حين رأى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقال إنها كانت محقة في كتابة نص كهذا، وهي الروائية الممكنة من شروط الفن التي ظهرت في رواياتها الأخرى.
س: هناك من يرى أن معظم الدراسات النقدية التي تناولت الرواية العربية، تحدثت عن السلطة السياسية أو سلطة الأيديولوجيا، القلة الذين تحدثوا عن سلطة الروائي، فما رأيك؟
ج: ما كان يكن للنقاد في بلادنا أن يتفادوا وطأة السلطة السياسية والأيديولوجيا معًا على النصوص، كما أنهم هم أنفسهم يراعون، في الغالب الأعم، هذين الأمرين حال اشتباكهم مع النصوص تفسيرًا وشرحًا وتأويلًا. فسواء تعامل النقاد مع الأدب بوصفه مقاومة حذرة أو متحايلة لاستبداد السلطة السياسية وفسادها، أو حتى للسلطة الدينية، وسطوة رأس المال النازعة إلى الاستغلال والاستهلاك، أو رأوه تعبيرًا عن الصراع الفكري والسياسي الذي يموج به مجتمع لم يبلغ التحديث والحداثة بعد، فإنهم استجابوا لقراءة النصوص من خلال هذين الحاحزين، أو على هاتين الأرضيتين.
لكن هذا لا يعني أن النقاد جميعًا انخرطوا في هذا المسار، فهناك بينهم من نظر إلى النصوص من خلال النظريات النقدية، مثل الشكلانية والبنيوية والبنيوية التوليدية والتفكيكية والسيمائية والاتجاه إلى القارئ وغيرها، سواء منها التي تحيل النصوص إلى سياقاتها العامةـ، أي ترى النص من خارجه، أو هذه التي تراه من داخله عبر كشف الظرف الذاتي لإبداعها، وكذلك التي تنشغل بجماليات النص وسيمائياته.
وفي نظري فإن النقد الأيديولوجي أو الذي يتعامل مع الأدب بوصفه مقاومة بالحيلة يتراجع وجوده بمرور الوقت، ليتعاظم دور النظريات النقدية سواء الواردة من الأكاديميات الغربية، أو تلك التي استلهمت ما في تراثنا العربي من تصورات نقدية، حسبما صورها لنا محمد مندور في كتابه “النقد المنهجي عن العرب الأقدمين”، أو هذه التي رأيناها في كتابات أمين الخولي وأحمد الشايب ومصطفى ناصف وعبد العزيز حمودة وعبد الفتاح كيليطو.
أما عن سلطة الروائي، فهي سلطة مرهونة بالكتابة، هي “سلطة المعرفة” كما يقول الفرنسي ميشيل فوكو، لكنها سلطة ذات تأثير ضعيف محاصر، لا تؤدي وظيفتها سريعًا، إنما تعول على الزمن، ووسيلتها إيقاظ الوعي أو تغذيته بما يجعل الفرد منتظمًا في الكفاح من أجل الحرية والعدل والكفاية.
وحديثي هنا عن تأثير بعيد المدى ليس مبالغة، ولا عزاء أقدمه لنفسي ككاتب، إنما هي حقيقة، والدليل سنعرفه إن قمنا بجردة حساب للمتداول من أسماء وتأثير البارزين من أهل الكتابة، أو أرباب القلم، في تاريخنا قبل مئات السنين، ومعهم أسماء الذين كانوا يحكمون وقتها، من أمراء وملوك وسلاطين وخلفاء، سنجد أن أسماء أهل الكتابة هي الأكثر تداولًا وتأثيرًا.
س: هناك سؤال يفرض نفسه في هذا المقام، يتعلق بسلطة الظروف القاهرة، وهنا يمكنني التحدث عن مبالغة الدراسات النقدية التي تناولت أثر هزيمة”٦٧” علي الرواية، فهل رأى أصحاب هذا الاتجاه في دراساتهم أن الهزيمة أصبحت قدرًا مقيمًا في النصوص الروائية، ولا فكاك منه؟
ج: تأثرت الرواية العربية بهزيمة يونيو 1967 دون شك، سواء على مستوى الكم أو الكيف. فبعد الهزيمة لوحظ غزارة الإنتاج الروائي العربي، وكأن الأدباء قد أرادوا أن يواجهوا الإحباط واليأس، الذي ترتب على الهزيمة، أو يتوسلوا بالأدب في تحليل الأسباب التي أدت إليها، ولمواجهة المتسببين فيها. وربما أردوا أن يسهموا في تعزيز الوعي بكل هذا لدى الجمهور الذي يتلقى الأدب بمختلف أنواعه، بل إن الأدباء أنفسهم استردوا وعيهم، من زاوية إدراك ضرورة الحرية للإبداع بشتى صنوفه، بما فيه الإبداع الأدبي، وكان عليهم أن يعبروا عن ارتقاء وعيهم هذا من خلال النصوص التي ينتجونها.
في الوقت نفسه صارت الهزيمة نفسها موضوعا لكثير من الروايات فرأينا اشتداد عود “أدب الحرب” و”أدب المقاومة”، ولأن الصراع ضد إسرائيل لم ينته رأينا تعزيزًا لهذين المسارين في الكتابة، بدرجات متفاوتة، بين رواية يمكن تصنيفها كلية على أنها من أدب الحرب أو المقاومة، وأخرى تأتي على ذكر الحرب مباشرة في موضع منها، أو تظهر تأثيرها على الحياة الاجتماعية العربية التي تستلهم منها النصوص.
وعلينا في هذا المقام ألا ننسى دور الأدب في التنبؤ بالهزيمة نفسها، حتى لو ارتدت هذه النبوءة ثوبًا رمزيًا مثلما رأينا في رواية نجيب محفوظ “ثرثرة فوق النيل”، التي انتبه قليلون إلى مغزاها قبل وقوع الهزيمة، ثم انتبه البقية إليها بأثر رجعي بعد وقوع الهزيمة.
س: هل يمكن للأيديولوجيا أو الظرف القاهر أو السياق بشكل عام أن يؤثر في هذا شكل العمل الفني عمومًا، والرواية خصوصًا؟
ج: يحدث هذا التأثير في بعض الحالات، لاسيما إن كانت مهارة الروائي ليست على ما يرام، فيأتي البناء الفني لديه آليًا وذاهبًا إلى ما يريد قوله من أقصر طريق، وكأنه في عجلة من أمره، وسيظهر انحيازه إلى الشخصيات الروائية التي تحمل أفكاره الذاتية، وليست بالضرورة فكرة الرواية، فقد يمكن الشخصية المنحاز هو إليها من احتلال المساحة الأكبر في الرواية، وقد يجعله المتحكم في الحوار، أو يظهره بطلًا إشكاليًا منزهًا عن كل عيب، ومبرأ من كل نقص.
فالأيديولوجيات الجامدة ترفض التعددية بالقطع، وتبخس حق وفرص أصحاب الأيديولوجيات المنافسة، ولذا لا تترك مساحة للمختلفين من شخصيات داخل النص الروائي، ليعبر كل منها عن نفسه، منتصرًا لرأيه وموقفه ومسلكه.
وبعض الأدبيات الخاصة بأيديولوجية معينة، واللغة المعبرة عنها، تتسلل إلى نصوص الروائيين الذين يسلمون رؤوسهم وقلوبهم للأيديولوجية، أو يحدث تناص معها، قد يكون مجرد تأثر، أو اقتطاف واقتباس واسع منها.